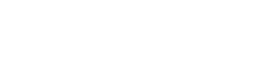السوريات.. السوريات! … عمر قدور
في خريف عام 2011، كنا في سهرة استضافتها سيدة في “جرمانا”، لوداع صديقين كانا سيسافران فجراً إلى حمص، بغرض إدخال مساعدات طبية إلى حي بابا عمرو المحاصَر آنذاك. كان الاحتيال على الحصار يحدث باستخدام بطاقات عمل تعود إلى قناة تلفزيون الدنيا، وهي الذراع الإعلامية الضاربة لشبيحة الأسد، وأيضاً لخطاباته الطائفية شبه الصريحة التي لم يكن قد بدأ يستخدمها في الإعلام الرسمي. وكان هناك العديد من النساء والرجال الذين عملوا في القناة قبل الثورة، ثم تركوها بعد اندلاعها محتفظين ببطاقاتهم.
في السهرة، كان ثمة فتاة غير معروفة من قبل، بينما تجمُع الباقين صداقات شخصية أو صحبة النشاط المتعلق بالثورة آنذاك. إزاء النظرات المستفهمة عن الطارئة الجديدة، عرّفها صديقنا فادي بالقول مبتسماً: إنها الرهينة. ملخّص القصة أن شبيحة الأسد في مدينة حمص كانوا قد بدأوا عمليات اختطاف طائفية، واستجرّوا عمليات اختطاف مقابلة. الحديث هو عن اختطاف النساء تحديداً، لما يحمله اختطافهم من إهانة اجتماعية ومن احتمالات تتعلق بالاغتصاب؛ بدلالاته الاجتماعية أيضاً لا الشخصية فقط.
إذاً، كان شبيحة الأسد قد اختطفوا نساء سنّيّات، والمطلوب اختطاف علَويّة أو علويات للمقايضة، أما إثبات الاختطاف من قبَل الجهة الخاطفة فكان يحدث بتصوير بطاقة الهوية مع صاحبتها وإرسالها إلى الطرف الآخر. الفتاة “الرهينة” مقيمة مع أهلها في دمشق، لكن قيد النفوس في بطاقتها يعود إلى حمص، وهكذا قررت أن تخاطر وتتسلل مع الذاهبين إلى بابا عمرو، وأن تسلِّم نفسها لكتائب الفاروق كي يُطلق سراح نساء لا تعرفهن.
مع حلول صيف 2012 كانت العسكرة قد راحت تطغى، لتزداد مخاطر النشاط السلمي. هذا لم يمنع سيدتين، إسماعيلية وعلَوية، من تجاوز الحواجز التي تحاصر مدينة يبرود، بهدف تقديمهما دعماً ما. صادف ذلك في شهر رمضان لتلك السنة، وكانت المراهنة الشائعة لتخطّي الحواجز بسلام هي على أن عناصرها يتساهلون مع النساء غير المحجّبات، إلا أن المخاطرة تبقى قائمة. في يبرود نفسها لم يكن الأمر يسيراً مع المحاصَرين جميعاً، فهناك من نظر بريبة وتوجّس إلى المرأتين غير المحجّبتين وغير الصائمتين، إذ ربما هما جاسوستان لصالح مخابرات الأسد.
وإذا كان تفهُّم التوجس من قبل أناس محاصرين مفهوماً، لو بقي في إطاره المباشر والضيق، فالأمر مختلف عندما يتخذ منحى التحريض الطائفي العلني. فقد شهدنا، على سبيل المثال ليس إلا، ناشطاً افتراضياً عن بعد، نال عدد كبيراً من المتابعين بفضل طائفيته التي كانت تزداد كلما استقطب مزيداً منهم. لم يتورّع ذلك الطائفي عن توجيه سؤال مسموم عمّا تفعله “العلوية” سميرة الخليل في الغوطة الشرقية، حيث كانت قد ذهبت وأقامت، وشاركت الأهالي الحصارَ المضروب على الغوطة.
الطائفي نفسه حرّض لأكثر من مرة على الكاتبة والروائية سمر يزبك بالتساؤل عما تفعله العلَوية في إدلب، والقول صراحةً إنها جاسوسة لنظام الأسد، لأنها كانت تتردد على إدلب بين عامي 2012 و2013، حيث كانت تقدّم المساعدة للنساء، وتنقل بكتاباتها لمنابر فرنسية صورة الكارثة الإنسانية التي يتسبب بها الأسد للأهالي. سمر يزبك هي مؤسِّسة منظمة “النساء الآن”، المنظمة التي قدّمت المساعدة للنساء في إدلب وغيرها في الداخل، وللنساء في مخيمات لبنان على نحو خاص، وقد نجح التحريض الطائفي عليها في زيادة منسوب الخطر من فصائل متطرفة في إدلب، فتوقفت عن الذهاب إلى هناك.
لم تفكر ريما فليحان كما كان يفعل ذلك الطائفي، عندما نشرت على صفحتها عقب اندلاع الثورة بياناً بعنوان: من أجل أطفال درعا. البيان الذي وقّع عليه أكثر من ألف شخص، وعُرف بـ”بيان الحليب” في أواخر نيسان 2011. فليحان نشطت كناطقة باسم لجان التنسيق المحلية، وعضو في المجلس الوطني ثم الائتلاف، ولم تُصوَّب الأنظار على كونها من منبت درزي إلا مؤخّراً، وعلى خلفية نشاطها الحقوقي من أجل مدينتها السويداء! كذلك هو حال الناشطة أليس مفرج التي اعتُقلت كالعديد من الناشطات والنشطاء في بدايات النشاط السلمي للثورة، من دون توقّف عند منبتها الاجتماعي قبل المجازر التي حدثت في السويداء مؤخراً.
فليحان ومفرج قدّمت كلّ منهما كلمة في “الحدث الجانبي” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف قبل أربعة أيام. في التظاهرة نفسها شاركت فرح يوسف وهنادي زحلوط، وقد ركّزت ورقة هنادي على مجازر الساحل التي فقدت فيها أخوتها الثلاثة، وثلاثتهم قُتلوا خارج القانون بلا ذنب سوى منبتهم العلَوي. سبق لهنادي أن اعتُقلت ثلاث مرات في سجون الأسد، ونالت ما نالته من تعذيب بسبب نشاطها الحقوقي السابق على الثورة واللاحق عليها، أي أن وجودها في جنيف هو استمرار لنشاطها الذي لا يتأثر بالمسألة الطائفية.
يمكن أن نضيف إلى ما سبق ذكرهن أسماء عديدة راح يُنظر مؤخّراً إلى منابتهن الاجتماعية على نحو لم يحدث من قبل، مثل الكاتبتين روزا ياسين حسن ونجاة عبدالصمد، وقد ساهمتا في إيصال أصوات الضحايا الجدد في الساحل والسويداء، مع تجربة سابقة لهما في مساندة ضحايا الزمن الأسدي. وليس من المصادفة وحدها أن يكون هناك تجاهل تام لجهود أنصار شحّود في الكشف عن خبايا “حفرة حي التضامن” التي ابتعلت الكثير من ضحايا الأسد، بينما استرجع البعض مؤخراً وعلى عجل دور شريكها الأجنبي، في خضم استعادة الذكرى بسبب وجود أحد متّهميها الكبار ضمن السلطة الحالية. ويُفترض نظرياً ألا نكون بحاجة للتنويه بالأعداد كبيرة من اللواتي ساهمن في الطور السلمي للثورة، وبالطبع ثمة الكثير منهن من منبت سُنّي. ويُفترض أيضاً، في وضع صحي مُفتقد، ألا نضطر لذكر المنابت الاجتماعية للنساء، طالما لم يخترنها ليُعرَّفنّ بها.
لقد خاطرت ألوف من النساء بحياتهن طوعاً، وعندما نشدد على الطور الأول السلمي فلأن العسكرة بطبيعتها بيئة طاردة للنساء، وهو ما حدث في سوريا بدءاً من عام 2012 حتى إسقاط الأسد، بل هذا ما سيبقى طالما بقيت الكلمة العليا للعسكر. الترابط لا يتعلق، كما قد يتبادر إلى الأذهان، بالطبيعة الفيزيولوجية للنساء، أو بتهربّهن من مواجهة الخطر، ففي الطور السلمي كانت الأخطار كبيرة، ولا ميزة تعفي النساء منها ضمن نظام إبادي. الترابط بين العسكر وطرد النساء مردّه أن أصحاب العسكرة بطبيعتهم ميالون إلى طرد مختلف الشرائح الاجتماعية من الفضاء العام، ويستخدمون على نطاق واسع سلاح التبخيس من قيمة النساء، لإقصائهن عن المشاركة المستحقة.
والخطير جداً أن يسود مزيج التغنّي بالعسكرة وسيادة أسوأ قيم الذكورة، وهو ما يحدث بالتقليل من أهمية إقصاء النساء عن الفضاء العام. يكفي النظر في الوظائف العليا التي عُيِّن أصحابها بعد إسقاط الأسد لرؤية تغييب الثقل الحقيقي للنساء، والاكتفاء بتمثيل رمزي لهن. تجاهل التغييب لا يبتعد كثيراً عن تجاهل اختطاف النساء على خلفيات طائفية، ففي الحالتين تُنتهك حقوقهن؛ مرة باحتسابهن غير مؤهّلات بناءً على طبيعة فيزيولوجية، ومرة باستخدام طبيعتهن الفيزيولوجية (أجسادهن) لإذلال مجموعات اجتماعية ينتمين إليها.
على الضد من التعاطي السائد، العمومي والطائفي، نزعم بأن سوريا بحاجة إلى حضور عام للمرأة يتناسب مع نسبة النساء، الأعلى حالياً من نسبة الذكور. الدافع لا يتوقف عند إحقاق العدالة في التمثيل، فالحاجة ملحة أيضاً للتخفيف من الثقافة التي تُعلي من القوة العسكرية وأسوأ ما في الذكورة معاً. ولا مبالغة في القول إن تقدّم النساء في الفضاء العام هو مشروع وطني في الحالة السورية، فنظرة سريعة على الفاعلين السوريين الطائفيين كافية لمعرفة أن نسبتهم الساحقة من الذكور، وأن نسبة النساء بينهم ضئيلة إلى حد لا يجعلهن مؤثِّرات. ومن المعلوم أن حرّاس الطوائف، وحراس نساء الطوائف تحديداً، هم تقليدياً من الذكور الذين يدّعون حراسة الفضائل.
في الخصوصية السورية أيضاً، نعود للتنويه بالدور المؤثّر الذي لعبته النساء في الكثير من البلدان بعد الحروب، فبُني جزء كبير من نهضتها بجهودهن. ومن المحتم أن الإقصاء المباشر وغير المباشر، وإشاعة أجواء الخوف، عوامل ستجبر السوريات على المزيد من الانكفاء، لتكون الحصيلة خسارة متعددة الوجوه والمستويات للبلد. والكلام هنا بأكمله ليس في إطار دعم معنوي لفئة يُنظر إليها على أنها فئة ضعيفة، فالواقع أن الكثير من السوريات قدّمن ما يتجاوز القسمة التقليدية بين الجنسين. والحديث عنهن يتجاوز الانتساب الشكلي لسوريا، ليذهب إلى المشروع الوطني العابر للطوائف، إذا كان قد تبقى له فرصة حقيقية.
.
.
عن المدن