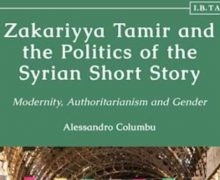ثقافة
“الإِبن السيء” فيلم وثائقي للمخرج السوري غطفان غنوم: سرديّة الذات المغيّبة وفصول القمع السلطوي
مروان ياسين الدليمي يمضي المخرج السوري غطفان غنوم في فيلمه الوثائقي»الابن السيء» إلى ناحية تفكيك إشكالية الثورة السورية ضد نظام الأسد، التي بدأت شرارتها في منتصف آذار (مارس) 2011. وبدا واضحا أن غنوم في...
اقرأ المزيدمن الصليبيين إلى زكريا تامر: سوريا في إصدارات 2023 .. صبحي حديدي
الكوارث الطبيعية اكتنفت العام 2023، من زلازل تركيا ومناطق في شمال وغرب سوريا، إلى زلازل وفيضانات المغرب وليبيا؛ وكوارث أخرى صنعها اقتتال جنرالات السودان، شركاء الأمس واليوم في الثورة المضادة؛ ثمّ العام إذ يجرجر...
اقرأ المزيد“نابوليون” الجديد يقدم القائد الفرنسي بقلب عاشق
النصف الثاني من الشهر الحالي وما يليه من أسابيع هو ملك “نابوليون”، الفيلم الجديد للمخرج ريدلي سكوت. لم يُكشف بعد عن ميزانيته، لكنها تقترب أو تتجاوز بقليل 150 مليون دولار، والطموح هو أن يتجاوز ضِعف هذا المبلغ...
اقرأ المزيدبعد تحقيقه الجائزة الكبرى للمسلسلات الوثائقية في مهرجان كان ،الوثائقي السوري “أماني خلف الخطوط” يحصد جائزة مهرجان Grand Bivouac الفرنسي
حاز الفيلم الوثائقي السوري “أماني خلف الخطوط” على جائزة بمهرجان Grand Bivouac الفرنسي وذلك بعد نيله جائزة أفضل سلسلة وثائقية في مهرجان كان الدولي. وعبر صفحتها على فيسبوك، كشفت المخرجة آلاء عامر أن فيلم (أماني/ خلف...
اقرأ المزيدالجمهور يحب لصوص البنوك انتقاماً
عندما سأل القاضي لصاً اعتاد سرقة المصارف “لماذا تسرق البنوك؟”، أجاب اللص ساخراً “لأن المال هناك”. وحسب رأي لص آخر قبض عليه في مدينة أوستن (تكساس) قال: “المصارف هي التي تسرقنا، ونحن نحاول استعادة ما تسرقه...
اقرأ المزيدالفيلم الفلسطيني «بيت في القدس» يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار فيلم «بيت في القدس» للمشاركة في النسخة الـ45 من المهرجان، ضمن فعاليات قسم «منتصف الليل». سيشهد هذا المهرجان العربي العرض الأول للفيلم، وهو من إخراج مؤيد عليان...
اقرأ المزيدالشاعر السوري نوري الجراح يتسلم أرفع جائزه أدبية فرنسية في باريس
يعتزم الشاعر السوري نوري الجراح تسلُّم جائزة ماكس جاكوب لعام 2023 عن كتاب “ابتسامة النائم” الذي يضمّ مُختاراتٍ من شعره ترجمها إلى اللغة الفرنسيّة أنطوان جوكي (منشورات سندباد/ أكت سود). وسيتم تسليم الجائزة...
اقرأ المزيدتأثير المتفرج… لماذا نميل إلى تصوير الضحايا بدلاً من مساعدتهم؟
لنفترض أن هناك حالة طارئة تحدث أمام عينيكم/نّ، فمن المؤكد أنكم/نّ ستتخذون/ن الإجراءات اللازمة لمساعدة الشخص الذي يواجه محنة معيّنة، أليس كذلك؟ قد نرغب جميعاً بالاعتقاد بأن هذا الأمر صحيح، غير أن علماء النفس رجّحوا أن تكون...
اقرأ المزيداغسلوا أيديكم بعد قراءة هذا الكتاب… “ليل الخلافة العثمانية الطويل”
في معظم البيوت العربية ستجدون أشخاصاً مسّهم طيف من الدراما التركية، وأسمع من أصدقاء وصحفيين حوارات حفظوها من مسلسلات تجعل السلاطين المؤسسين في مصاف العباقرة الملهمين. يتبارى هؤلاء المساكين في استعادة مشهد، وترديد حواره، بإعجاب...
اقرأ المزيدنستطيع إنجازالمهمة.. كتاب جديد يوثق نجاحات لاجئين سوريين في ألمانيا
كتاب توثيقي نشر في ألمانيا بجهود شخصية، ليرصد قصص نجاحات اللاجئين في ألمانيا بأسلوب جديد. أراد المؤلف تسليط الضوء على فئة واسعة من اللاجئين يرى أن الإعلام أهملها أو تجاهلها. فما ميزه هذا الكتاب، وماهي هذه القصص التي يضمها بين...
اقرأ المزيد