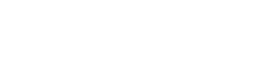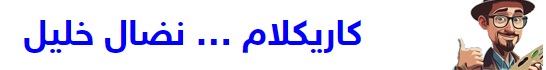مهند قطيش: قصة متأخرة من سجن صيدنايا! … راشد عيسى
مع هروب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وسقوط نظامه، بدأت قصص وعذابات لا حصر لها بالتدفق، بعضها شاهدناه بأم العين على بوابات السجون، ولا ندري إن كان بإمكان الخارجين بعد أن يقصّوا مآسيهم، فكثير منهم فاقدو الذاكرة أنساهم السجّان حتى حليب أمهاتهم، أما أولئك الذين كُبسوا بالمكابس المعدنية الثقيلة، أو ذُوّبوا بالأسيد، فيبدو أن السبيل الوحيد إلى رواياتهم شهادات سجّانيهم.
هذه قصةٌ ناجية رواها أمس الممثل السوري مهند قطيش في مقابلة، بعد عشرين عاماً على خروجه من السجن، إذ كان مجرداً من كل حقوقه، وممنوعاً من الاقتراب من الصحافة، ومن العمل من دون إذن. ولعلنا لاحظنا بالفعل غيابه، أو حضوره القليل، في الدراما التلفزيونية والسينما مقارنة بأبناء دفعته من الممثلين السوريين (باسم ياخور، قاسم ملحو، شكران مرتجى، فرح بسيسو).
قضى الممثل السوري 3 سنوات (من العام 2002 وحتى 2005) في سجن صيدنايا بسبب انتقادات، في مقالات صحافية، وجهها لشركة إنتاج تلفزيوني كانت تسيطر على سوق الدراما التلفزيونية آنذاك، ويملكها أبناء نائب الرئيس عبدالحليم خدام.
مقابلة حافلة بالمفارقات، أولاها أن الضابط الذي حقق مع قطيش هو أنور رسلان، الذي يخضع اليوم لعقوبة السجن في ألمانيا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. رسلان، رئيس قسم التحقيق في الفرع المعني، استقبله بالإشارة إلى دوره في مسلسل “الزير سالم”: “أهلاً بِسَلَمَة”، وحسب الفنان لم يكن يتحدث إلا بالفصحى. وعندما جرى تحويله، بعد تحقيق وتعذيب لـ33 يوماً، قال له، مستعيراً عبارة من حكاية الزير سالم نفسها: “ذهبتَ بشسع نعل كليب”، و”نصبنا فخاً لحوت، فوقعتْ سمكة”.
عند إعلان محاكمة هذا الضابط، قبل حوالى عامين، ثار جدل كبير بين السوريين، فرسلان كان معارضاً ممن انشقوا عن النظام عند محاكمته، وتَشَعَّبَ السجال حول الرسالة التي يمكن إرسالها لمنشقين محتملين، وحول أن “الثورة تجبّ ما قبلها”، والأكثر غرابة اتهام المنظمات الحقوقية السورية بأنها تتصيد فقط المنشقين المنتمين إلى الطائفة السنية، فيما يُترك الحبل للآخرين!
تأتي شهادة قطيش لتنزع إمكانية التعاطف مع الضابط الأمني المنشق، فليست هذه صورة “العبد المأمور”، المغلوب على أمره، فلُغته انتصارية، متشفّية، مدعية ومتثاقفة فوق ذلك. وبالإمكان بالطبع لمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار أن الرجل صحا ضميره في لحظة وأعلن انشقاقه، لكن ذلك سيؤهله لعقوبة أخف، لا لإلغاء المحكمة والحكم.
إذاً فقد أُرسل قطيش إلى سجن صيدنايا، وبعلمه أنه يحاكم على انتقادات صحافية، لكنه سيكتشف لاحقاً أنه بات بعيون الشارع السوري جاسوساً لإسرائيل، هذا ما روّجه النظام وأفهمه لكل سائل عنه: “انسوه، قصته كبيرة، تمس أمن البلد، تخابر مع دولة عدوة”.
هذا الجزء بالذات ترك مرارة هائلة لدى الفنان، ففوق الظلم هناك هذه العزلة والحصار الاجتماعي، وتواطؤ الناس ضده، وسهولة تصديقهم للإشاعة.
وهذا جانب لا يخص الفنان وحده، فعائلته كلها أصبحت موضع نبذ. هنا يلمّح الفنان إلى ما تعرضت له عائلته الصغيرة، زوجته وابنته، أشار إلى غدر وخيانة الأصدقاء، إلى محاولات الابتزاز والتحرش، وترك بقية الحكاية لزوجته، معتبراً أن الروي هنا يخصها، هذه قصتها هي. خصوصاً بعد أن باتت لها أسرة أخرى.
كان هناك جزء من تجارة النظام المخلوع واستثماراته يتعلق بذوي المعتقلين، فلطالما جرى ابتزازهم بتدفيعهم أموالاً طائلة، غالباً مقابل معلومة مزيفة أو خادعة. ذوو المعتقلين جاهزون لدفع ما فوقهم وما تحتهم من أجل رائحة خبر عن أعزائهم. نعرف واحدة من الحالات ظل أحد ضباط الأمن يطلب من ذوي معتقل ما يحلو له ولزوجته على مدى سنوات، قبل اكتشاف العائلة أن ابنها المعتقل قضى منذ سنوات.
عندما أنهى مهند قطيش حكمه استدعاه هشام اختيار، أحد القادة الأمنيين الأكثر دموية في النظام والذي سيقتل في تفجير “خلية الأزمة”، مع بدايات الثورة في سوريا، ليفرج عنه، سأله الفنان: “اعتقلتموني كل هذه الفترة، دمرت حياتي، بسبب مقال ينتقد أبناء عبدالحليم خدام، وأنا أخرج اليوم لأجد أن سوريا كلها، والبرلمان ليس لهم سيرة سوى حكاية الفاسد عبدالحليم خدام”. كان خدام قد انشق حينها وترك البلاد، وتحولت البلاد برمتها إلى خلية نحل تصحو وتنام على شتمه.
ليس مهماً ما كان جواب اختيار على سؤال الفنان، فلطالما كانت الأمور هكذا، فهل هناك أوضح أن “سوريا الأسد” التي تتزعم تاريخياً محور الممانعة، والتي تزعم أنها العدو الأول لإسرائيل، كانت الأكثر مهادنة له، وجبهتها هي الوحيدة الهادئة على مدى ستين عاماً!
ولعله اليوم ينظر مجدداً بعين أخرى لسجن صيدنايا، فلقد كان قريباً جداً من مشاهد أفظع من الحال الذي كان فيه، من دون أن يدري. لعله اليوم ينجو من جديد. ولا ندري إن كان صالحاً هذا المعيار الذي أدمنّاه؛ أن نقيس أمورنا بالأسوأ. بالمصير الأفظع الذي ذاقه الآخرون، أن نعتبر أنفسنا ناجين مما مضى، وبالتالي سيكون أي شيء أمامنا مدعاة للتفاؤل والأمل.
* كاتب من أسرة “القدس العربي”