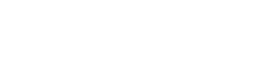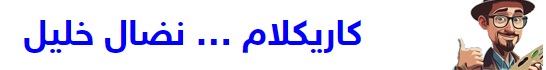ثقافة غربية بجلباب عربي .. سفيان الميموني مشبال
أصبح مجتمعنا العربي من الناحيتين الأخلاقية والإنسانية تائهاً لا أصالته في يد ولا المعاصرة المرغوب فيها في يده الأخرى، يبتغي التقدم والتطور السريعين ومحاكاة المجتمعات المتحضرة ولو على حساب أصالته وثقافته اللتين تحددان هويته. لكن قبل بناء موضوعنا يجب أن نضع له أرضية، وهي أن المشكل ليس في التطور والتحضر، نحن نريد ونتمنى ذلك لنا حتماً. المشكل في كيفية وطريقة وصوله إليهما؛ لأنه اختار التقليد الأعمى بدل الدراسة المعمقة. قصته كذاك الغراب الذي أراد أن يقلد طريقة مشي البطة، فلا هو أتقن مشيتها ولا هو عاد يمشي كالغربان، فبقي معلقاً بين الاثنتين.
يجب أن نتفق أولاً على أنه رغم التنوع الأيديولوجي الذي يشهده مجتمعنا حالياً، فإنه اتخذ الإسلام عقيدةً له بحكم الأغلبية الشعبية والسلطات الدستورية، لكن هذا لا يعني أن الكل متخلق حسب معايير الدين الإسلامي، ولا يعني أيضاً أن البقية لا أخلاق لهم، لكن الأكيد أن وضع العرب لا يبشر بالخير ويصل بنا لنهاية الطريق قبل بدء الرحلة.
تعكَّرت مياه أخلاقه بالماديات، الملاهي، الشهوات، الأنانية، وكيف لا المصلحة الذاتية. وعندما يقوم أحد بتسليط الضوء على مشكلتهم يجيبونك وحفنة تراب التعصب موجهة نحو بصرهم وبصيرتهم أنّ هذا ما أرتأوه وأن هذه هي الوسطية المثلى في مسايرة العصر وغيرها من الخزعبلات المنتحرة فيها لغة العقل والمنطق.
وأنا أكتب هذا المقال بحرقة حول مجتمعنا الذي يمشي على رأسه ويفكر برجليه، تذكرت -على سبيل المثال- مشاهد من الشارع المغربي والتي أجزم بأنكم رأيتموها في مجتمعاتكم أو ربما حالفكم الحظ وأتت إلى عتبة داركم، أتكلم عن شباب سُلبت منهم هويتهم وقلدوا كـ”الأعمى في الظلمة” من لا أخلاق لهم، وبنساء انشغلن بالموضة ومتابعة مسلسلات فارغة من المعاني والأخلاق تحطم كل أرقام المواد السمعية البصرية. ورجال استعمروا المقاهي يتغذون فيها بالنميمة والكلام الذي لا يأتي أكله.
وبهذا نتكلم فقط على رأس البئر، فما بالك إذا حاولت التعمق والتنقيب ستنصدم بالأرقام المخيفة حول قضايا الإجرام عن طريق المخدرات أو الطائفية؛ الدعارة السوداء المنظمة، والأكثر سواداً تلك التي تمارس باسم الدين كزواج القاصر والمتعة والرق؛ والانتحار بسبب فضائح الإنترنت والحب المراهق، ومشاهد أخرى أجنبني وإياكم الكلام عنها احتراماً مني لكم. وفي المقابل، تبحث عن القيم الأصيلة والأخلاق الرفيعة فلا تجد ما يشفي غليلك.
لكن هذا لا يعني أن لا وجود لها، يكفي أن تزور أقرب بادية لك وستجد ما أتحدث عنه وترى الفوارق الصارخة بين المدينة التي أطلقوا عليها اسم “الحضارية” والبادية “غير الحضارية”. وهنا أطرح سؤالاً: هل الحضارة تتجلى في انعدام الضمير الأخلاقي والطغيان المادي على الجانبين الروحي والإنساني؟
على ما يبدو، “الإنسان على شكله يقع”. وزلة الإنسان العربي كانت ضخمة لدرجة أنّي لم أجد لها وحدة قياس. فبعد أن كان هو المتقدم في سلم الحضارة والتي من خلالها بسط أخلاقه عالمياً وذاع صيته ليتهافت عليه أصحاب العقول النيرة من كل صوب، وما إن بنى أعمدته الشامخة حتى سقطت وتدهورت ليفسح المجال لوافد جديد أخذ لُبَّه وترك له القشور على أنها سلعته الأصلية، وكرَّس التقدم والرقي ديناً له. أمسك بمربط الخيل، وطوَّر إمكانياته العلمية والاقتصادية والصناعية والسياسية وأصبح الكل يصفق لإنجازاته ويبارك وينحني لعظمته. ولم يسلْم مجتمعنا هو الآخر من سيله الجارف.
ما يمكن احتسابه لمجتمعنا هو أنه رفض في بادئ الأمر تغيير جلبابه، لكن رفضه لم يدم طويلاً حتى فوجئ بخلعه واستبداله بقميص “غير ساتر”. وهنا حصل له ما حصل لصديقنا الغراب: “لا استطاع الرجوع لجلبابه المحبوب ولا هو ترك ذاك القميص العصري الذي آلفه”!
غير أن الأمور لا تقف عند حدّ اللباس؛ بل تتجاوزه إلى طريقة التعبير، والتفكير، والأكل وحتى التصرف. التقليد الأعمى وموضة “خالف تُعرف” أصبحت ذاك المنتوج الذي يملأ فراغ شبابنا وبناتنا، وحتى أطفالنا الذين كُتبت عليهم هذه العدوى.
لماذا نغطي الشمس بالغربال إذاً؟ لم هذا النفاق الاجتماعي؟ أنريد معاصرة “الغرب الكافر” وأصالة “أولاد البلد” في الوقت نفسه؟ نريد ثقافة الجار على حساب ثقافة بيتنا؟ نريد ثقافة غربية بجلباب عربي؟ متى امتزج الزيت بالماء حتى تمتزج ثقافاتنا؟ وهذا ما نراه جلياً خارج الأوطان العربية حينما يخرجون في مظاهرات أو تجمعات لنشر فكرهم “غير النفعي” على أنه الصلاح والأصل. يهللون لمن وافقهم ودعمهم ويردحون لمن خالفهم.
دعوني أقل لكم باختصار: لكل مجتمع خصوصياته الثقافية، والدينية، والاجتماعية. ومن ثم، فلكل حضارة بريقها وفق شروط شعبها الداخلية وإمكاناتهم الخاصة، إن غيَّرتَها انقلبت ضد نفسك وعشت أبد الدهر متناقضاً حتى في أبسط قراراتك. وهنا أطرح سؤالاً آخر: هل تمكن الوطن العربي من الفرز بين قيم الحرية والمساواة في الدين وفي القوانين الوضعية حتى يحلم أساساً بالجلوس حول مائدة العالم المتحضر؟
أظنه استطاع جزئياً من الناحية الخارجية فقط، كالهندام غير المتناسق والتعبير السطحي الأنجلوعربي والعرنسي. ولم -ولن- يُوفق قطعاً من الناحية الداخلية؛ لأنه يشهد صراعاً دموياً بين الضمير الطبيعي للهوية (ما تربى عليه) والتقليد الأعمى الذي يحبون تلطيف لفظه بكلمة “التحضر”. أي إن حالته النفسية متكسرة إن لم أقل مطحونة. وهنا أستحضر مثال الفتيات اللائي يلبسن الحجاب في رؤوسهن والسراويل اللاصقة في أجسادهن. يكفي أن تسألهن ليُجبنك بأنهن غير مرتاحات لهذا اللباس؛ لأنه غالباً يكون مفروضاً عليهن من طرف الآباء أو أرباب العمل. لذلك تقف المسكينة مضطربةً وتائهةً عقلياً بين سعد الغامدي وسعد لمجرد.
أو عن الفتيان الذين يلبسون تلك السراويل والقمصان المشدودة التي تصعِّب عملية جريان الدم في الشرايين؛ ما يعسر وصوله للعقل ليمارس مهامه الطبيعية كالتفكير والتمعن في شكلهم البهلواني مثلاً، أو قَصات الشعر واللحية الغريبة. ما إن تمر أيام معدودات على ظهور “نيولوك” الرياضي هذا أو الممثل ذاك حتى ترى المدينة تطغى بنسخه المشوهة، وقس على ذلك عزيزي القارئ.
أختم بسؤال أخير: أين ذهبت عفة وحياء أمهاتنا، وشجاعة ومسؤولية آبائنا؟ كيف؟ ومن يربون أبناءنا، هل فعلاً يهتمون لتربيتهم؟ متى نستيقظ من النوم؟ هل نحن أحياء أصلاً؟!
كاتب من المغرب العربي