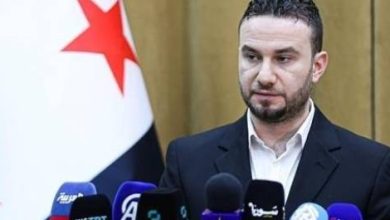“رصاصة عابرة”.. هل يوقع السلاح المنفلت سوريا في دوامة عنف لا تنتهي؟
رصاصة تقنص طفلا هنا وتفتك بحياة هناك، هكذا هي سوريا اليوم إذ لم يعد السلاح حكرا على عناصر الأمن والجيش، بل صار حاضرا في تفاصيل الحياة اليومية، ما يثير خوف الأهالي ويغذي حوادث السرقة والاعتداءات، وفي حين تستمر محاولات السلطة للسيطرة عليه تكشف الأرقام عن انفلات أمني يثقل كاهل السكان.
فبحسب تقديرات أمنية فإن أكثر من 90 في المئة من الأسر السورية تمتلك سلاحا فرديا واحدا على الأقل، في حين ترتفع النسبة بين الأفراد في المناطق الحدودية لتصل إلى مايعادل 85 في المئة، ومع محاولات إعادة بناء مؤسسات الشرطة والقضاء يجد بعضهم المجال مفتوحا لتحصيل الحقوق باليد، فمن اغتيال في شارع جانبي إلى رصاص يتناثر في ساحات المدن وصولا إلى ما وقع من انتهاكات وجرائم في الساحل والسويداء.
سلسلة أحداث لا تعكس سوى حقيقة واحدة تقول إن السلاح صار سيد المشهد في سوريا حيث تشير مصادر خاصة إلى أن إجمالي عدد الأسلحة الفردية المتداولة يتراوح بين 8.5 و 10 ملايين قطعة سلاح في حين 35 بالمئة من المناطق الريفية تمتلك سلاحا متوسطا، مايعكس حجم الانتشار وخطورته، وفق مصادر أمنية خاصة.
من مستودعات النظام إلى السوق السوداء
في خبايا الأحياء الضيقة وبين طيات الصحراء والجبال تتسلل الأسلحة إلى يد أي باحث عن حماية أو نفوذ، إذ يكشف تحقيق معتمد على أرقام غير رسمية أن السلاح في سوريا ينتشر من أربعة مصادر رئيسية وهي من المخازن العسكرية القديمة مرورا بالسوق السوداء التي لا تنام، وصولا إلى الدعم الخارجي للمعارضة السورية وغنائم النزاع، وهكذا تكبر كميات السلاح في كل زاوية من المدن السورية تاركة ورائها صدى الرصاص وحكايات الضحايا.
بعد سقوط النظام شهدت سوريا انفلاتا واسعا في سوق السلاح، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير وأصبح السلاح عملة رائجة نتيجة لعمليات السطو على مستودعات النظام المخلوع. وتشير أرقام غير رسمية إلى أن نحو 160 ألف بندقية في دمشق وحدها اختفت بالكامل.
في كل زاوية من الشوارع السورية يتسلل الخطر بصمت، رصاصة طائشة، نزاع قديم، أو لحظة جنون واحدة تكفي لتغيير حياة عائلة كاملة، ومع انخفاض سعر الأسلحة في سوريا بعد سقوط النظام وتحوله لعملة رائجة إثر عمليات السطو على مستودعات النظام المخلوع، تقول تقديرات غير رسمية إنه “في دمشق وحدها كان يوجد نحو 160 ألف بندقية اختفت جميعها”.
من المخازن المهجورة إلى الحدود المفتوحة، السلاح أصبح جزءا من الحياة اليومية للسوريين في غياب للقانون وازدياد للضحايا، ويعزو الخبراء انتشار السلاح إلى عدة عوامل أهمها أن ملايين السوريين مدربون عسكريا ضمن النظام السابق عبر المدارس والجامعات والخدمات الإلزامية ما جعل أكثر من 6 ملايين سوري قادرين على استخدام السلاح، كما أصبح السلاح وسيلة لتحويل المال بسرعة من دون عراقيل.
وبحسب مصادر غير رسمية تعرضت مخازن السلاح التابعة للنظام المخلوع لعمليات نهب منظمة من قبل ضباط خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017، في حين أدخلت الأسلحة الخارجية المقدمة للمعارضة أصنافا جديدة من السلاح الأميركي والأوروبي مما زاد من التنوع وانتشار الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.
ليلة السقوط بدت البلاد كما لو أن قلبها توقف عن النبض الليل كان شاهدا جديدا على تفشي غير مسبوق للأسلحة محولًا البلاد إلى سوق مفتوحة، إذ تشير تقارير حديثة إلى أن سوريا قد تسير على خطى ليبيا وأفغانستان كمصدر رئيسي لتهريب السلاح.
ووفقًا لتقرير Inkstick Media بعنوان “سوريا قد تؤجج أزمة تهريب الأسلحة”، تم تسجيل أكثر من 121 حادثة ضبط أو تسليم أسلحة بين ديسمبر 2024 ومارس 2025 في سوريا ولبنان، ما يعكس حجم الانتشار غير المنضبط للسلاح رغم محاولات المجتمعات والسلطات الانتقالية الحد منه.
ما أنواع السلاح المنتشر في سوريا؟
وأنت تمشي في الشوارع السورية ستلاحظ أن الأسلحة تتناثر كما لو كانت بضائع عادية، مسدسات صغيرة تسكن جيوب المارة، بنادق تزين رفوف بعض المنازل وذخيرة تباع لمن يملك المال، تفاجئ بأن الناس يعرفون كل نوع من الأسلحة بمجرد سماع صوتها لتكتشف أن السلاح في سوريا لم يعد مجرد أداة بل أصبح جزءا من حياة .. من شارع .. ومن بيت.
تقرير Inkstick Media كشف عن حجم خطير وغير مسبوق لانتشار الأسلحة في سوريا بعد انهيار نظام الأسد. ففي حادثة واحدة فقط بتاريخ 11 من كانون الأول/يناير، أوقفت الشرطة اللبنانية مركبة على الطريق السريع بين سهل البقاع وبيروت، وعثرت على عشرات الأسلحة وآلاف الطلقات المهربة من سوريا، بينها خمسة بنادق هجومية روسية 9A-91 كانت مخصصة لوحدات النخبة في الجيش السوري، واعترف المشتبه بهم بتنفيذ أكثر من خمس عمليات تهريب إضافية إلى لبنان.
وتكشف الحوادث الأخرى وصورها أن بنادق هجومية، قنابل يدوية، قاذفات صواريخ آر بي جي، قذائف هاون، صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وأنظمة دفاع جوي محمولة (MANPADS) منتشرة على نطاق واسع، بما في ذلك نماذج روسية وإيرانية وصينية ومن دول الكتلة السوفيتية السابقة، التي استخدمتها “قوات النظام المخلوع” على نطاق واسع.
السلاح تهديد أمني ومجتمعي
تغيرت ملامح الوجوه في الشوارع، يلعب الأطفال بحذر والكبار يمشون متوجسين من أي صوت مفاجئ، الحوادث المتكررة تركت أثرها على كل عائلة؛ خوف مستمر؛ فقدان للأمان وتوتر دائم يرافق كل لحظة.
لم يعد انتشار السلاح في سوريا مجرد مسألة أمنية بل أصبح تهديدا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا في الوقت ذاته، فالعنف والجرائم تتصاعد والعلاقات المجتمعية تتوتر، ومن خلال حديثنا مع الباحث طلال المصطفى أستاذ علم الاجتماع في جامعة دمشق والباحث في مركز حرمون للدراسات أكد أنه من أهم الآثار النفسية على السوريين المدنيين التي تصيبهم بسبب انتشار السلاح تتمثل بداية بتصاعد القلق والهلع الاجتماعي، حيث وجود السلاح بيد الجميع يزرع خوفا دائما من اندلاع نزاع مسلح حتى لأسباب تافهة، بالإضافة إلى انتشار ثقافة العنف كآلية للتفريغ النفسي، فالسلاح يمنح شعورا وهميا بالقوة والسيطرة خصوصا للأشخاص المهمشين أو من فقدوا مكانتهم الاجتماعية.
ونوه المصطفى إلى أن معالجة هذه الظاهرة تحتاج إلى سياسات متكاملة لنزع السلاح، مرافقة ببرامج دعم نفسي مجتمعي وإعادة بناء الثقة وإلا ستبقى سوريا عالقة في دائرة عنف لا تنتهي.
السلاح الفردي عنصر للسيطرة المحلية
وفي حين ركّز الباحث على الانعكاسات المباشرة لانتشار السلاح على البنية الاجتماعية والعلاقات المحلية، قدّم الأستاذ محسن مصطفى، المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية والباحث في مركز عمران للدراسات، مقاربة أوسع تناولت الأبعاد الأمنية والاقتصادية والتشريعية لهذه الظاهرة. وأشار إلى أن الصراع في سوريا فرض الحاجة إلى التسلّح بمستويات ونوعيات مختلفة، وهي حاجة ازدادت حدّتها مع تصاعد وتيرة المواجهات. ومع تفكك منظومة الضبط الأمني لاحقاً، أصبحت الأسلحة الفردية والمتوسطة عنصراً محورياً في المعادلات المحلية، ليس بوصفها أدوات قتال فحسب، بل كوسيلة للهيمنة والسيطرة أيضاً.
أما على الصعيد المجتمعي تحدث مصطفى أن غياب الدولة، أو غياب التشريعات الناظمة أو تعطيلها، في تحويل السلاح إلى طرف فاعل في النزاع، وفي توسيع هامش التسلح الفردي، سواء لأغراض الحماية الذاتية أو لتصفية نزاعات محلية الطابع.
هذا الانتشار العشوائي للسلاح أدى إلى تحويل الخلافات الاجتماعية إلى مواجهات مسلّحة، خاصة في المناطق الريفية والعشائرية.
سوريا و”اقتصاديات السلاح”
أما اقتصادياً، أفضى توفر السلاح بيد الأفراد والمجموعات المحلية إلى نشوء ما يمكن تسميته بـ”اقتصاديات السلاح”، حيث تداخلت تجارة السلاح مع التهريب، والجباية، وسائر الأنشطة غير المشروعة. وقد نتج عن ذلك دورة مغلقة من العنف والتهرب من القانون، دفعت شريحة واسعة من الشباب إلى الانخراط في تشكيلات مسلّحة، بحثاً عن مورد مالي أو عن حماية، ما عمّق من أزمة التنمية ومزّق النسيج المجتمعي الهش أصلاً.
وإذا كان الجانب الأمني والاقتصادي قد عكسا حجم الإشكالية فإن البعد التشريعي يكشف الحاجة الماسة إلى إصدار قانون وطني جديد ينظّم حيازة السلاح، يتضمّن تصنيفاً دقيقاً للأسلحة المسموح بها، وآليات واضحة للترخيص والمراقبة، مع تحديد الجهات المخوّلة بالضبط الأمني، وفرض عقوبات صارمة على من يثبت حيازته أو تجارته للسلاح من دون ترخيص. إذ لا يمكن لأي مقاربة أمنية أن تنجح دون مرجعية قانونية واضحة تُعيد احتكار استخدام القوة بيد الدولة، وتحدّ من الفوضى القائمة.
في هذا السياق، يبرز أيضاً ضرورة تفعيل برامج شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)تستهدف الفاعلين المحليين المسلحين. على أن تتجاوز هذه البرامج المقاربة الأمنية، لتتضمن مكوّنات اقتصادية واجتماعية فاعلة، من قبيل توفير فرص العمل، ودعم المبادرات الصغيرة، والتأهيل المهني والنفسي للعناصر المسرّحة. فقد أثبتت التجارب الدولية أن نزع السلاح لا يتم بالضغط وحده، بل عبر تقديم بدائل واقعية ومستدامة للحياة المدنية.
وأخيراً، فإن إشراك المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في عمليات الرقابة والوساطة يشكّل ركيزة أساسية لضبط هذه الظاهرة.
إذ يمكن لهذه الهيئات، متى ما تم دعمها وتمكينها، أن تؤدي دوراً محورياً في الحد من دوافع حمل السلاح، سواء عبر تسويات محلية، أو من خلال مبادرات التوعية المجتمعية.
كما أن إدماج فئات الشباب في مشاريع تنموية وخدمية يُعد خطوة أكثر جدوى من أي تدبير أمني تقليدي، ما لم يُستند إلى بنية اجتماعية قادرة على إعادة إنتاج الأمن بصورة مستدامة.
إن ما سبق يبيّن بوضوح أن انتشار السلاح في سوريا لم يعد مجرد ظاهرة عابرة مرتبطة بظروف النزاع، بل تحوّل إلى تهديد بنيوي للأمن المجتمعي والاقتصادي على حد سواء. ولعلّ المثال الأوضح على ذلك ما شهدته مدينة حمص خلال شهر آب، حيث سجّلت مشافي وزارة الصحة بمحافظة حمص وقوع 36 إصابة بطلق ناري، من بينها 12 إصابة نتيجة رصاص طائش، ثلاث منها خطيرة في الرأس. هذا المثال، وإن اقتصر على مدينة واحدة، لكنه يعكس حجم المأساة التي خلّفها السلاح المنفلت، ويكشف في الوقت ذاته صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة تشمل مختلف المحافظات السورية.
وبذلك، تتضح الحاجة الملحّة إلى بناء مقاربة وطنية شاملة، تستند إلى التشريع والتنمية والمجتمع المحلي، كمدخل أساسي للحد من تداعيات هذه الظاهرة والانتقال نحو استقرار مستدام.
.
.
تلفزيون سوريا ـ كاترين القنطار