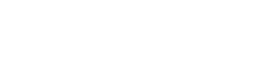زياد رحباني المأسوف على شبابه .. راشد عيسى
لا يُلام الفنان زياد رحباني، أياً كان محتوى الفيديو المسرّب، الذي بث على «تيك توك» ، ثم على فيسبوك، لمقابلة أجريت في منزله، وبغرض تعليمي، عندما اقتحمت بيته معلمة في مدرسة خاصة، طارحةً، من دون أي رحمة أو شفقة، سؤالاً تلو آخر، على الفنان شبه المعتزل، والخَجِل من ردّ طلباتها وأسئلتها.
مسرّب لأنه في غير موضعه، فالمفترض أن الفيديو موجّه لطلبة مدرسة بعينها، فكيف حدث أنه بات بين أيدي العموم؟
لذلك لا جدوى من معاينة الفيديو كمقابلة تستحق التقييم من بوابة المهنية، حتى من باب الصلاحية البيداغوجية، إذ ما الذي يمكن لطلبة المدارس أن يتعلّموه من فيديو كهذا غير: «كيف تقتحم فناناً في عزلته وتسلّط عليه فجأة كل أضواء التواصل الاجتماعي المبهرة»، أو: «كيف تجري مقابلة مع فنان مشهور تكون فيها الأسئلة والأجوبة في آخر سلم الأولويات»، ومن هذه الناحية لن يفيد الفيديو إلا باعتباره دعاية استثنائية مضادة للمدرسة التي عليك تجنّب إرسال أولادك إليها.
إن شئت الحق فإن الفيديو يدفع إلى التضامن مع الفنان، فهو، في النهاية، ضحية مقلب غادر.
ولربما كان تحوّل الفنان إلى ضحية، إلى جانب الحالة البائسة التي بدا عليها، وخصوصاً ما آلَ إليه صوتُه، كفيلاً بتأكيد حقيقة الزمن: لقد بات زياد في آخر عقده السابع، وكان بإمكانه ألا يدخله البتة. أي أن يبقى شاباً مضيئاً ملهماً أبداً، وهنا حضرت نبرة الرثاء أكثر من اللوم.
كان زياد رحباني مُعلّماً بحق، لا الأستاذ صاحب العصا في المدرسة، بل ذلك الذي ترك علامة واضحة لا تنكر عند أجيال. كنا نحفظه عن ظهر قلب، موسيقا، ومسرحيات، وإن كانت هذه مسرحيات إذاعية نتناقلها في كاسيتات سبقت زمن الميديا الاجتماعية، حفظنا أخفض صوت فيها، الخطى، والهمهمات، والقفشات، ولعلنا حاولنا بناء أشياء وعبارات مماثلة، سنوات بحالها ونحن نضحك للنكتة نفسها، وباتت لغتنا، لغة جيل بحاله، منسوجة من لغة زياد رحباني. ولا ينفي المرء أنه حتى اليوم يشتاق ويستعيد ويستمع: «فيلم أمريكي طويل»، و«بالنسبة لبكرا شو؟»، «شي فاشل»، «نزل السرور».. والبرنامج الإذاعي التحفة «العقل زينة»… ويا له من زمن إبداعي ساحر!
وقد يصح بالفعل وصفه بزمن إبداعي، إذ تجتمع إشاراتٌ عديدة تدفع للاعتقاد أن ذلك الإبداع كان شغل مجموعة، لا شغل زياد وحده، وبات واضحاً، سنة وراء سنة، عملاً وراء عمل، أن زياد من دون الأسماء التي كانت برفقته تَحوّلَ إلى أضحوكة، لا مضحكاً، خصوصاً عندما راح يستغرق في أحاديث السياسة، بل حتى قبل ذلك.
وبالنسبة لي، كانت صدمتي الأولى في تلك المقابلة التي اتهم فيها موسيقى التونسي الرائع أنور إبراهام وموسيقى اللبناني ربيع أبو خليل بـ «الموسيقى التي يريد الغرب أن يصنعها بالنيابة عنا، ويصدرها للعالم باسمنا. هذه هي الموسيقى التي يصنعها الصهاينة في العالم بدلاً من العرب»، وصولاً لاتهام إبراهم بأنه يهودي، ولم يكن الرجل كذلك، وقد تكون طريقة لفظ اسمه بالتونسية هي ما أوحى للرحباني بذلك.
وسرعان ما ثبت أن المبدع التونسي مسلمٌ، واللافت، حينذاك، أن الجهة (دمشق عاصمة الثقافة العربية) التي دعت زياد رحباني إلى دمشق، هي ذاتها كانت قد دعت الفنان التونسي إلى فعالياتها، وكانت معلومات جواز سفر الأخير بين يديها، وتعرف الحقيقة، ولكنها اكتفت بالتواطؤ مع رحباني بالصمت.
كذلك سرعان ما ثبت أن الفنان التونسي متضامن، وربما أكثر من زياد، مع «المقاومة»، فأصدر تصريحاً حينذاك، بعد اتهامات زياد، ليقول إنه حقق فيلماً في بيروت بعد عدوان تمّوز، بعنوان «كلام ما بعد الحرب»، محتجاً على اتهامه بأنه يدين برواجه العالمي إلى «الصهيونية»، متسائلاً: «ومنذ متى، نحاسب الآخرين على أساس انتمائهم الديني؟ علماً بأنّي ولدت في تونس من أب مسلم وأم مسلمة، وتربّيت على احترام كلّ الأديان والمذاهب والعقائد».
وفي الواقع، تلك التصريحات لم تكن شيئاً بالقياس إلى تصريحات لاحقة لزياد تتعلق بانحيازه إلى التيار الممانع ضد الاستقلاليين اللبنانيين، وتالياً وقفته العنيدة ضد «الربيع العربي»، ووقوفه مع نظام دمشق، بل تفضيله لمخابرات النظام على معارضيه، وحلمه بنظام دكتاتوري كستالين، وولعه بالاستماع إلى خطب حسن نصر الله، وتوريطه لوالدته فيروز، ذات مقابلة، بإفشاء حبها للسيد (حسن نصر الله)، ما جعل الخلاف يدب مجدداً بين النجل والوالدة.
مرّ زمن طويل، على الأقل منذ عقدين، وزياد يعيد نغمته الراسخة ذاتها إلى جانب النظام الممانع ومع بقاء نظام دمشق، بل لم يتورع عن الدفاع عن نظام الملالي مباشرة، حين سئل عن إيران: «لا أخاف من إيران نووية، الإيرانيون هم من يجب أن يخاف، فهم أقلية في بحر من البلدان السنّية».
وكنا قد استبشرنا خيراً، في مرات قليلة، بأن المبدع قد يصحو، أو ينتبه، بعد إغفاءات وغيابات محدودة، وأنه قد يلاحظ أن أجيالاً من محبيه بالذات باتوا لاجئين خارج بلدانهم، أو اعتقلوا وقتلوا عند من يناصر، فينقلب من جديد، لكنه كان يبتعد ويغوص أعمق فأعمق.
غَطّ طويلاً في غفوته الأخيرة، إلى أن فاجأتْنا صاحبةُ المدرسة بهذه المقابلة المحزنة.
سنتين أخريين ويدخل زياد في السبعين، هنالك دائماً أمل، ولو في ربع الساعة الأخير.
؟
؟