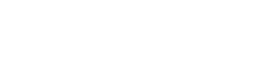فخ الأسماء في لبنان.. التطبيع مع القرداحة.. وممنوع الكلام لميشيل خليفي.. راشد عيسى
نقاش آخر في لبنان، البلد المليء بالقضايا والنقاشات التي لا تفضي إلا إلى مزيد من القضايا والنقاشات، أثارته جمعية المقاصد الخيرية في قرارها إعفاء كل تلميذة جديدة تحمل اسم خديجة، أو فاطمة، أو عائشة، أو زينب، من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى خصم من قيمة القسط السنوي.
القرار اعتبر تمييزاً بين الطالبات بسبب أسمائهن، بسبب ما ليس للمرء فضل فيه، في وقت قد تجد تلميذات بأسماء محايدة، وربما قرر أهاليهن إعطاءهن تلك الأسماء المحايدة لتجنب التمييز سلفاً على الاسم، في بلد كان الذبح فيه يوماً على مجرد الاسم والهوية، قد تجد أنهن أحق، قياساً للحال الاجتماعي، بحسمٍ وتخفيض.
في بلاد مثل فرنسا، حيث الرأسمالية المتوحشة، حسب قاموس الممانعة، وحيث الغرب المارق، حسب أبواقهم الصدّاحة، ما يتوجب دفعه (وهو ليس تماماً مقابل التعليم، فهذا مجاني حتى المرحلة الثانوية) مقابل أشياء مثل المطعم في المدرسة، أو بعض الفعاليات والأنشطة الإضافية، يتحدد بموجب دخل كل تلميذ (دخل ذويه طبعاً)، ولربما كان ذلك أفضل تمثيل للعدالة. يستحيل أن تجد أحداً، في فرنسا، يستحق التكريم أو التمييز بقرار معلن، أو حتى مخفي، لمجرد الاسم.
ولا ينفي المرء أن تمييزاً من هذا النوع قد ينشأ بطرق مواربة، ولشدَّ ما صدمني ذات مرة، في سنواتي الأولى هنا، في باريس، عندما تعرفتُ إلى «مسيحي» لبناني، يحمل اسماً مسيحياً صريحاً، وكذلك أطفاله، إلى أن زلّ لسانه مرة فنادى على ابنته باسمها الأصلي، فكان اسماً إسلامياً مركباً من مفردتين تشيران فوراً إلى طائفة الرجل. ولم يكن أمام السيد اللبناني، حامل الجنسية الفرنسية، إلا أن يصرّح بأن اسمه الأصلي محمد. تصوّر! الرجل المسلم حين قرر أن يبدّل اسمه، كنوع من التقية، لم يختر اسماً محايداً؛ نبيل، سليم، جميل، بل ذهب تماماً إلى الضفة الأخرى. وبالطبع راح يسهب في الشرح كيف أن الفرنسيين يميزون حسب الاسم، وما قد يترتب على ذلك من فرص الترقية، بل وفرص الحصول أصلاً على وظيفة.
لا ندري بالضبط مدى مصداقية ذلك، أو دقّته، ولربما كان الفارق، لو صدق الرجل، لا يستحق هذه العملية المعقدة، وهي في أساسها شكل من الكذب، وحقنه (الكذب) في دماء أبنائنا. أنت تعطي اسماً لولدك لأنك تريده على هَدْي وخطى صاحب الاسم الأصلي، لكنك، في المقابل، تسلّمه رسالة مناقضة.
يحتاج بلد مثل لبنان، البلد النموذجي للحرب الأهلية المديدة، أن يخفف ما يؤجج ذكريات الحرب والحواجز. أن يمنح المرء تكريماً ومزايا بفضل الاسم، قد يعني في العمق احتقاراً وتبخيساً من الاسم في الجهة المقابلة، في الضفة الأخرى من خطوط التماس.
ملتقى القرداحة
نقرأ أخباراً هنا وهناك عن فعاليات ثقافية في إطار «ملتقى القرداحة»، ومن البديهي أن نتخيل أن تلك الأنشطة تجري في تلك المدينة، التي ينتسب إليها مؤسس الوحشية السورية حافظ الأسد، لكن، على ما يبدو، أن أمسيات الملتقى القرداحي متنقلة بين مختلف المدن السورية، فهذا واحد في حي المزة الدمشقي، وذاك في مدينة حمص، ولا يستبعد أن نشهد ملتقى قرداحياً قريباً في ضاحية بيروت الجنوبية.
قال، نظّمَ ملتقى القرداحة الثقافي مهرجاناً شعرياً بعنوان «شقائق الغزل»، قدم فيه شعراء «مختلف ألوان الشعر»، و«نفحات العشق» و«شتاء القبل…».
ليست المشكلة في أن مدينة ما ليس بإمكانها أن تنجب شاعراً، مع أنه لو حدث لهجّجوه، أو أعدموه، المشكلة هي في قصدية ترويج اسم المدينة، والتطبيع معها، في وقت هي رمز لكل إذلال، وتشبيح، وقتل.
كان السوريون، إن أرادوا اختيار مدينة وسط، اختاروا دمشق، رمزاً وتاريخاً ومعنى، وإن أرادوا اعتماد لهجة بيضاء وسط لمسلسلاتهم وأفلامهم اختاروا الشامية، الدمشقية، التي بات المغاربة اليوم يتحدثون بها، بعد أن كانت قصية وصعبة.
«ملتقى القرداحة» ليس اسماً بريئاً، ولكن لن ندعو، البتة، إلى إقصائه، بالعكس، هو اسم لائق تماماً بهذه الحقبة الأسدية، يجب أن تكون الأشياء بهذا الوضوح.
ميشيل خليفي
لا أذكر أني صادفت مقابلة تلفزيونية جديدة مع المخرج السينمائي الفلسطيني ميشيل خليفي، فالرجل بعيد عن الأضواء، ربما بحكم إقامته البلجيكية، وقلة إنتاجه في السنوات الأخيرة، ولذلك هرعت بشوق لمشاهدة هذه المقابلة المصورة، برغم أنها كانت على قناة «الميادين».
التقيت هذا السينمائي الناصري المخضرم في فعاليات سينمائية فلسطينية في فرنسا، منذ سنوات، وكان مليئاً بالذكريات الفلسطينية النادرة، وبحديث فلسطيني طازج ودافئ. لدي ذكرى طيبة للغاية من ذلك اللقاء، فعندما عرف أنني من قضاء طبريا (أبي من مواليد الطابغة) راح كلما تذكر وذكر شيئاً عن طبريا يشير إليّ بالقول: «عندكو». وكم كنت سعيداً بذلك. شعرت بأنني منحت فجأة مكاناً، كلما قال لي «عندكو في طبريا»، شعرت بأن المكان يهدى إليّ من جديد. أنا الذي أنتمي إلى أجيال قد لا تعرف فلسطين إلا ذهنياً.
في مقابلته الجديدة، كان خليفي عالقاً بين يدي مذيع ثرثار، يريد أن يتحدث أكثر مما يستمع، وفوق ذلك بدا ممانعاً نموذجياً في محاولة الأستذة ومنح الشهادات.لا أدري كم من المرات قال للمخرج «برافو»، وفي واحدة منها أعطاه «جيد جداً».
كنا سنقبل لو أتاح، في المقابل، للمخرج أن يتحدث، أن يسهب، لو استطاع أن يستفز شهوة الكلام والبوح، والذكريات، والسينما، والأحلام. عبث.
؟
؟
؟
؟
*كاتب من أسرة تحرير «القدس العربي»