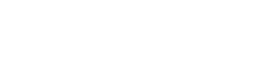لم يمنعهم حجابي من التحرّش بي .. إلهام الجمال
“إيمتى هاتلبّسي بنتك الحجاب؟”. سؤال صادم قذفته إحداهن في وجهي ذات ظهيرة، بينما أنتظر طفلتي في النادي لتنهي تمرين الكاراتيه.
طفلتي لم تبلغ سن ارتداء الحجاب بعد، فلماذا تشغل تلك السيدة بالها بفكرة لم تشغل بالي في الأساس؟ أحب أن ترتدي ابنتي الحجاب، لكني أحب أكثر أن ترتديه بحب، ليس فقط انصياعاً لأمر أو استجابة لنصيحة.
رغم امتناعي عن الردّ ومحاولتي تجاهل السؤال لإيصال رسالة غير مباشرة لها بعدم التدخّل في أمور خاصّة؛ لم تنتظر مني إجابة وواصلت حديثها بحماس، كما لو أنها قد أخذت على عاتقها هدايتي من المعاصي التي اقترفتُها يومياً لتفوز هي بالجنة. صبّت في أذني عبارات إنشائية محفوظة ومكرّرة عن فضل الحجاب وأهميته في عفّة الفتاة المسلمة والشاب المسلم على حد سواء، فإخفاء البنت لمفاتنها يعفّ الرجال، ويحفظها لرجل واحد يفوز بها بالحلال.
استرسلت في كلامها وشجّعها صمتي، لكنها لم تدرك أنني بعد دقيقة واحدة بنيت بين أذني وعبارتها المحفوظة سدّاً، وشردت لأتذكر أنني قد ارتديت حجابي في سن الثانية عشرة، وعلى الرغم من ذلك لم تحفظني قطعة القماش من أيدي المتحرّشين ولا بنت بيني وبين عيون المتطفلين جداراً. على الرغم من كوني مصرية أعيش في بلد الأزهر الشريف، الذي علّم العالم الإسلام وأصوله. يحاوطني الشعب المتديّن بطبعه في كل مكان؛ لكنني عانيت، كغيري من نساء هذا البلد على اختلاف هيئاتهن وأعمارهن، من التحرّش والتطفّل والتحكّم والتدخّل فيما أرتدي وما أفعل وما أقول.
حجابي وثيابي الفضفاضة لم تمنع أحدهم من الالتصاق بي في وسيلة مواصلات عامة، متعلّلاً بشدة الزحام. لم تمنع يد أحدهم من التسلّل لمؤخرتي فجأة بينما أقف في طابور العيش أنتظر دوري لأفوز ببعض أرغفة
لا يدرك الآخرون أن ذاكرة الأنثى في مصر تحتفظ رغماً عنها بكل فعل تحرّش تعرّضت له. فالألم الذي يتركه هذا الفعل القبيح في نفسها؛ لا يمحيه زمن ولا تهزمه أيام، والغريب أن الأمر لا يقتصر على عمر أو ثقافة او مستوى اجتماعي، فالفيروس قد أصاب أغلب الرجال في بلدي، إلا من رحم ربي.
تواصل جارتي في المقعد نصائحها المعلبة عن ضرورة ارتداء ابنتي الحجاب في أسرع وقت، بينما أتذكّر طفلة صغيرة كُنتها ذات يوم. عندما أتممت العاشرة من عمري وبدأ جسدي يتشكل، فرحت كثيراً بضفائري التي تطول مع الأيام، وبروز صدري الذي بدأ يكبر رغم أنه كان يشعرني كثيراً بالخجل. مرّة، وبينما أقطع شوارع القرية جرياً، وتزلزل ضحكتي الأرجاء؛ تلتقطني يد عجوز قرّر فجأة أن يحكم ذراعيه حولي ليلجم حركتي في وضح النهار، ويتحسّس صدري البارز، ويقبض عليه بقسوة وهو يردّد ضاحكاً: “وريني كده خراط البنات خرطك ولا لسه”، فأغضب وأشعر بالاشمئزاز والخوف، وأحاول التخلّص من ذراعيه بدفعه بعيداً عني، لكن جسده كان أقوى من ضعفي.
يعبر المارة من أهل القرية حولي، يضحكون للمشهد الذي لم يكن ساخراً بالمرة. ضحكات لم يفهم عقلي الصغير سبباً لها، زاد معها خوفي؛ فأبدأ في ضربه لإبعاده، فيتركني دون أن يتخلّى عن ضحكاته السمجة هو والمحيطون.
لم تحمني طفولتي وبراءتي من تحرّش عجوز هائج على قارعة الطريق في وضح النهار. لم ينتبه أحد لألمي، بل نصحوا أمي بأن تلبسني الحجاب كيلا يثير صدري عجوزاً مسكين آخر، لكنها لم تفعل إلا حين أتى أمر ربي.
ارتديت الحجاب أولاً انصياعاً لأمر ديني، وثانياً خضوعاً لتقاليد اجتماعية توارثها أهل قريتي، لكنني مع الوقت أحببته وارتبطت به، ليس لأنه يحجب العيون عني، كما تقول جارتي في المقعد بحديقة النادي الرياضي، والتي راحت تواصل درسها الديني كما لو أنها تقف على منبر مسجد تخطب في العامة.
لكنني وقعت في غرام حجابي بلا سبب، فالحب المرتبط بسبب يزول بزوال السبب، كما قال أحدهم، لذلك لم أتعب نفسي في البحث عن أسباب. يكفي اقتناعي بأنه أمر ربي، وهذا وحده يكفيني.
في الجامعة، وبابتعادي عن قريتي ضيقة الفكر والمساحة؛ تصوّرت أنني سوف أتعامل مع بشر مختلفين، يقدّرون المرأة ويحترمون حريتها، محجّبة كانت أو لا. بشر يؤمنون بأن المرأة كائن حر مستقل بذاته، كامل الأهلية، قادر أن يقرّر القبول أو الرفض، القرب أو البعد، إعلان الحب أو الحرب. لكن للأسف لم أجد ما تصورته، فالغالبية ينظرون للمرأة على أنها جسد وملامح، لا عقل ولا روح.
؟
؟
؟
؟
؟