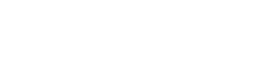شحاطة ام احمد تتفوق على ماكرون … مرهف مينو
 رغم الفرق الكبير في التغطية الإعلامية بين حادثة صفعة ماكرون وحادثة “أم أحمد الديرية” في دمشق، إلا أن المقارنة بين الحادثتين تُظهر مفارقة لافتة في التأثير الشعبي ورد الفعل الجماهيري ، المشهد أظهر بريجيت وهي تلمس وجه زوجها بطريقة وصفها البعض بأنها “صفعة”، ما فتح الباب أمام موجة من التأويلات والتكهنات التي سرعان ما اجتاحت الإعلام ومواقع الإنترنت.
رغم الفرق الكبير في التغطية الإعلامية بين حادثة صفعة ماكرون وحادثة “أم أحمد الديرية” في دمشق، إلا أن المقارنة بين الحادثتين تُظهر مفارقة لافتة في التأثير الشعبي ورد الفعل الجماهيري ، المشهد أظهر بريجيت وهي تلمس وجه زوجها بطريقة وصفها البعض بأنها “صفعة”، ما فتح الباب أمام موجة من التأويلات والتكهنات التي سرعان ما اجتاحت الإعلام ومواقع الإنترنت.
وانتشر بسرعة، وتحوّل إلى قضية رأي عام داخل فرنسا وخارجها، حيث وصفتها وسائل الإعلام بـ”الإهانة للديمقراطية”، وتناقلتها كبريات الصحف وشبكات الأخبار.
في البداية، نفى قصر الإليزيه صحة الفيديو، قائلاً إنه “مزيف ومُفبرك باستخدام الذكاء الاصطناعي”. إلا أن هذا التوضيح لم يصمد طويلاً، إذ تبيّن لاحقاً أن الفيديو حقيقي ومن تصوير وكالة أنباء محترفة.
عندها، غيّر الإليزيه روايته وأوضح أن اللقطة “أُسيء فهمها”، مؤكداً أن الأمر لم يكن سوى لحظة مزاح بين الزوجين، حيث وضع ماكرون تعليقاً طريفاً، فقامت زوجته بوضع يدها على فمه لإسكاته.
أما حادثة أم أحمد، السيدة السورية التي صفعت موالية للنظام في قلب دمشق وصرخت ضد بشار الأسد بعبارة “شواربهم تسوى لحية يلي خلفوج”، فقد أحدثت زلزالاً رمزياً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحوّلت في أوساط السوريين إلى تعبير عن الكرامة، ورفض الخنوع، والانفجار الشعبي الكامن تحت رماد القمع.
ورغم غياب التغطية الإعلامية الرسمية الدولية، فإن تفاعل الجمهور السوري والعربي مع حادثة “أم أحمد” فاق ما تم تسجيله في صفعة ماكرون على مستوى رمزية التحدي، والسياق السياسي الخطير الذي جاءت فيه، وجرأة المواجهة في قلب عاصمة كان يحكمها الخوف.
حادثة “أم أحمد” تفوقت من حيث التأثير الرمزي والشعبي، حتى إنّها غطّت على حادثة الرئيس الفرنسي ماكرون في الأوساط السورية، وبدت وكأنها صفعة معنوية للنظام ذاته، لا لمجرد موالية للمخلوع بشار الاسد.
في فرنسا، كانت الصفعة إهانة رمزية لرئيس منتخب، أما في دمشق، فكانت الصفعة رفضاً بطولياً لديكتاتورية بائدة كانت مدججة بالخوف والموت.
الناس يعرفون الفرق جيداً، ولهذا هتفت القلوب لأم أحمد أكثر من الرئيس الفرنسي.
أخلاق الشبيحة بموجز قصير،
محامية من منطقة الدحاديل في سوق الخضرة تفتعل شجاراً بسبب سب بعض الأشخاص لبشار الأسد وإيران! pic.twitter.com/HAYowFNutI
— وائل الملاح (@wael_albattan) May 25, 2025
خيبة وواقع مر
تكوّنت لدى معظم السوريين صورة واضحة ومقلقة عن الواقع الذي تعيشه البلاد اليوم، واقع يختزل مزيجاً من الخيبة والغربة وانعدام الأمل. فبدلاً من أن تكون العودة محطة بداية لحياة جديدة، باتت محطة اصطدام بجدار تحديات متراكمة، تبدأ من غياب البنية التحتية، ولا تنتهي بانفلات السوق وعودة وجوه النظام البائد.
العائدون، وهم في غالبيتهم من الفئات الأكثر تضرراً من الحرب، عادوا إلى مناطق مدمّرة لا تحتوي على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، ليعيشوا كغرباء في مدن هجّرتهم منها الحرب، لتستقبلهم بالإهمال والخراب. لا استقرار حقيقياً، ولا جهود ملموسة لإعادة الإعمار، لا من الجهات الحكومية ولا من المنظمات التي يُفترض أنها معنية بدعم الناس. ما يسمعونه من وعود لا ينعكس فعلياً في حياتهم اليومية، التي تزداد قسوة يوماً بعد يوم.
إيجارات المنازل تضاعفت بشكل جنوني، في مدن ما تزال مهدّمة، دون أي رقابة أو ضبط، ما يعيد إنتاج التهجير الداخلي ويدفع كثيرين إلى المغادرة مجدداً أو العيش في ظروف غير إنسانية. السلع الأساسية باتت بعيدة المنال، والرقابة غائبة، بينما الدخل لا يغطي أدنى متطلبات المعيشة.
التعليم الجيد أصبح ترفاً لا تقدر عليه سوى قلة، بعدما تحوّلت المدارس الخاصة إلى عبء مرهق، دون أن تعوّض المدارس العامة هذا النقص بجودة حقيقية. أما القطاع الصحي، فقد تحول إلى تجارة مفتوحة بلا رقيب، يهدد الأمن الصحي للعائلات ويزيد من شعورهم بالخذلان.
المفارقة الكبرى أن جزءاً من النخبة الاقتصادية الحالية هم أنفسهم تجار النظام السابق، أولئك الذين راكموا ثرواتهم على حساب الدم والدمار وارتفاع الدولار. عادوا اليوم بوجوه جديدة، يتحكمون بمفاصل السوق، ويعيدون إنتاج منظومة التسلط ذاتها، ولكن بلغة أكثر نعومة وأقل ضجيجاً، مما عمّق من شعور الظلم لدى العائدين، الذين يرون أن تضحياتهم لم تُترجم إلى عدالة أو فرص حياة كريمة.
يتحكّم هؤلاء بما تبقى من الاقتصاد، من الإيجارات وأسواق الغذاء، إلى مسارات الإعمار، بذات الذهنية الاحتكارية ولكن بأدوات أكثر أناقة. وهذا لا يُعد استمراراً لنهج قديم فحسب، بل إعادة إنتاج مُمنهجة لمنظومة التسلط الاقتصادي، ما يجعل مفهوم “التحرر” لدى المواطن العادي يبدو شعاراً فارغاً أمام واقع أكثر قسوة.
المؤلم أيضاً هو الغياب الكامل للمنظمات الإنسانية التي لطالما تباهت بدورها في “إعادة الإعمار” و”التمكين المجتمعي”. وجودها اليوم لا يتعدى التصريحات والمنشورات الترويجية، أما على الأرض، فالكثير من العائدين لم يتلقوا أي دعم حقيقي في الترميم أو سُبل المعيشة. أصبحت تلك المنظمات وكأنها تعمل في فضاء موازٍ لا علاقة له بالواقع أو بحاجات الناس العاجلة.
هذا الواقع يُنذر بأن حلم العودة الذي راود الملايين قد ينقلب إلى كابوس، إذا لم يتم اجتثاث منظومة الفساد من جذورها، لا فقط بإسقاط واجهتها السياسية، بل أيضاً بتفكيك شبكاتها الاقتصادية والاجتماعية التي ما زالت تعيد إنتاج ذاتها داخل خرائب المدن والقلوب.
الحكومة الجديدة، رغم إدراكنا لحجم التحديات التي تواجهها، لم تبادر بعد إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لضمان حقوق العائدين. الناس لا يطالبون بأكثر من حقوقهم الأساسية: سقف يأويهم، تعليم لأبنائهم، طبابة في متناولهم، وكرامة تليق بتضحياتهم. هي مطالب لا تستدعي ميزانيات ضخمة، بل إرادة سياسية جادة، وتنظيماً كفؤاً وعادلاً للموارد.
ما نشهده اليوم ليس مجرد تأخير في الخدمات، بل انهيار في الثقة، ونفور متزايد من العملية السياسية والاجتماعية التي من المفترض أنها جاءت لإصلاح ما دمرته سنوات القمع والحرب. وإذا استمر تجاهل هذه الأزمة، فقد نواجه مستقبلاً لا يختلف كثيراً عن الماضي، إلا في أسماء المتنفذين وأساليب القمع.
العدالة لا تعني فقط محاسبة الجناة، بل أيضاً ضمان حياة كريمة للناجين. وأي مسار لا يضع هؤلاء الناس في أولوياته، هو مسار يُعيد إنتاج الظلم بكل أشكاله.