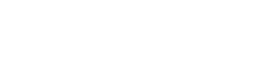سوريّون لكن شوايا … منية حسون
في بداية تعارفنا سألني زوجي الفرنسي، ما معنى «شوايا»؟ كانت لحظة طريفة لكن مربكة. ترددت، كيف سأكون عادلة في شرح هذه الهوية المعقدة. الدافع وراء سؤاله كان حديثاً جمعه في باريس مع صديق وحبيبته السورية العاملة في المجال الإنساني، قالت له حين ذُكرت دير الزور: «هدول شوايا».
قبيل الثورة، وبعد مرور ما يقارب الثلاثين عاماً على مجازر النظام السوري في حماة الثمانينيات، رُوي لي أن الجرح الحموي ينكأ في السرّ كلما ذُكرت دير الزور، لأن ذاكرة المجزرة تخللتها الحكايات عن ميليشيات عنيفة شاركت النظام في العمليات الممنهجة للذبح والنهب، كان أفرادها يتكلّمون «شاوي»، قيل أنهم من دير الزور. اليوم وبشكل أكثر عنفاً وفجاجة، تعود التنميطات المجتمعية حول «الشوايا» – أو بتسميتها الملطّفة في الفضاء العام، «العشائر» – إلى حلقة تشكيل العلاقات بين السوريين؛ ليس بدءاً من العنف المعنوي الذي غالباً ما يختصر ملامح هذه الهويّة ببعد واحد من نظرة تحقير طبقي، ولا انتهاءً بحوادث يرويها لي الأصدقاء في سوريا عن النبذ المجتمعي الذي يتعرَّض له الـ «ديريون» اليوم؛ الـ«شوايا» بطبيعة الحال. تكرار حوادث صغيرة من قبيل ازدرائهم، تجاهلهم المباشر في الأسواق، ورفض أصحاب المحالّ في عدة مناطق سوريّة بيعَهم السلع في افتراض لصلتهم بمليشيا العشائر التي انتهكت السويداء، هي في الحقيقة عقوبة نبذ مجتمعي قائمة على عنف ثقافي ذي بعد سياسي، ترسمه خيالات تنميطية ضيّقة، ذاكرة جمعيّة مكلومة، وتراكم لسرديّات ظِل غير مكتملة.
يُنظَر شعبيّاً إلى أبناء المنطقة الشرقية وحضارة الفرات بضفّتيه شاميّّة وجزيرة، وبعض مناطق الشمال والوسط والجنوب على أنهم كتلة واحدة مصمَتة؛ عشائر من رعاة الإبل والشياه وبقايا بدو رحّل، متخلّفين، عالقين -لا يزالون- في محاولات التمدّن. أذكر حين كنت طفلة قصّة عن مدرّس انتُدب من الساحل إلى مدرسة ابتدائية في دير الزور الثمانينيات. روى كيف بكت أمّه عليه لأيام، وودّعته القرية وداع الماضي إلى حتفِه لأن في دير الزور «أكلة لحوم بشر». لم تختلف الصورة كثيراً بعد عدة عقود، ففي سنيّ الدراسة الأولى في جامعة دمشق، كثيراً ما أجبت عن أسئلة فيما إن كنّا في دير الزور نعيش في خيم أم في بيوت حقيقية، نركب السيارات أم فقط الجِمال، وإن كنّا قد سمعنا بالإنترنت. كانت تلك أسئلة جادّة من قبل زملاء، شابّات وشبان سوريين، قادمين من خلفيّات اجتماعية وثقافية متباينة، تجاوزت أعمارهم الثامنة عشر آنذاك.
تشكّل نظرة استشراقية نحو هذه المناطق وثقافاتِها الوعيَ الجمعيّ السوري. لا فرق حقيقي بين ريف وبادية، مدينة وبلدة، شرق، أم وسط، أم شمال، كلّ هؤلاء «شوايا» إگزوتيك، يتكلّمون لغة لثوية غريبة بمخارج حروف مقلِقة، عنيفون، متخلّفون، مكانهم الهامش. ديناميكيات مشابهة تشكّل وعي وعلاقة أبناء مدن تلك المناطق بالبلدة، والقرية، والبادية، بطريقة لا تقلّ عنفاً في الحقيقة. بالمقابل، لا تخلو هذه النظرة الاستشراقية من الرَّمنسة، التي تأتي محمّلة أيضاً بصور نمطية مفرطة في الإيجابية يلفّها سحر القيم الإنسانية العليا – التي في عمقها قيم مجتمعية وتكافلية – من قبيل الرجولة والكرامة والكرم والفروسية وإغاثة الملهوف وغير ذلك. نتذكّر «فزعة العشائر» للمناطق المتضررة في زلزال تركيا وشمال سوريا عام 2023، كيف ترافقت مع صور شاعرية كثيفة احتفى من خلالها الفيسبوك السوري بالثقافة نفسها التي ينال منها اليوم. لا تختلف قصة البارحة عن الأمس في العمق، فالاثنتان فيهما نزوع نحو الإكستريم والتعميم.
المشكلة الأساسية بالصور النمطية التي ترافق سردية الاستشراق ليست في جزئية تقاطعها مع الواقع من عدمه، بل في كونها تضع البشر والمجتمعات في خانات نحو أقصى الخير أو أدنى الشرّ، لا توافق الحقيقة، بل صورتنا عن هذه الحقيقة بالضرورة. على نحو مشابه لما طرحه إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق (1978)، حول كيفية بناء «الغرب» لتصور نمطيّ عنيف عن «الشرق»، يُكرّس تفوّقه الثقافي والسياسي ويبرّر هيمنته واستغلاله لتلك المجتمعات الأقلّ منه في الإنسانيّة، تُساهم السلطات القمعية في أوطاننا – ومن قبلها الاستعمار – في التأسيس لتصوّرات وهميّة عن تفوّق ثقافة أحدنا على «الآخر». من خلال هذا التنميط، تسعى السياسات السلطوية إلى ترسيخ أشكال رمزية من «الانتصارات» الثقافية وتسييسها، وخلق جو من الحذر الدائم المتوارث، العابر للأجيال. هكذا، ندور جميعاً في حلقة مغلقة من الضحايا و«ضحايا الضحايا» وفقاً لتعبير سعيد البليغ، في مجتمعاتٍ تتقاسم المأساة. يقع ضمن هذا الإطار تصنيف فئات مثل «الشوايا» و«البدو» – وفي صيغة أكثر صوابية: «العشائر» – في أسفل هرم الثقافة والإنسانية السورية المنتهَكة أصلاً.
لم يحالف السوريين الحظُّ في نظام تعليمي نقدي، برامج إعلامية وطنية أو أدوات ثقافية حقيقية تسائِل هذه الصور النمطيّة التي غرسها النظام في وعيهم الجمعي. بالنتيجة، لم يُعرف عن محافظة دير الزور (مثلاً) الممتدّة على ريف ومدينة وبلدات وبادية، سوى ما أتاح لهم نظام حافظ وبشار الأسد رؤيته عبر عدسة الصور النمطية منزوعة الإنسانية؛ «شوايا»، بسطاء، سُذّج، غير «متمدّنين» وغير حضاريين، يمجّدون القائد في ختام برامج «رسالة الدير» و«أرضنا الخضراء» على القناة السوريّة الأولى، ويُلقَّنون ما يتوجّب عليهم قوله أمام كاميرا البعث. سيأتي اليوم الذي ستخدم هذه الصورة النمطية وصور مشابهة لمجتمعات سوريين آخرين، سياسة القمع نحو الشعب المحكوم، سيقال أنه لا يستحقّ الديمقراطية لأنه لا يعرف ما معنى الحرّية. سيستحقّ كثير من السوريين القتل بتأييد شعبي أو بتضامن رخو بأحسن الأحوال، كنتيجة طبيعية لنزع الإنسانية الممنهج عنهم باعتبارهم أدنى في هرم الثقافة والإنسانية ولاحقاً الوطنيّة.
أسوةً بكثير من المناطق السورية، اختبر أبناء الـ «شوايا» شعوراً بالانتماء مرتبكاً نحو وطن لا يجمعهم على قدم المساواة والمواطنة مع غيرهم من السوريين. على مدار العقود، عزل نظام البعث هذه المناطق عن المركز بطريقة مؤسساتية ممنهجة، منسجمة مع سياسة عمّقت نظرة مجتمعية متعالية نحو أبنائها. رُسّخت الصور النمطية عبر وسائل الإعلام «الوطنية»، وأنظمة التعليم والثقافة والخدَمات على اختلاف مستوياتها. في الوقت ذاته، عمل نظام حافظ وبشّار الأسد على استمالة بعض عشائرها وإلحاق أفرادها بالأجهزة الأمنية، غالباً في مراكز سلطوية هامشيّة، تخدم أجندته وتطلق أيديهم إلى الفساد والرشوة مقابل الولاء. شكّل هؤلاء جزءاً لا بأس به من المنظومة القمعية الأسدية التي قايضت ولاءَهم بتغذية شعور لاهث نحو القيمة، من موقعهم على الهامش المقترن بالعار المسكوت عنه من ثقافاتهم؛ لهجاتهم، زيّهم، عاداتهم، وتقاليدهم، وغير ذلك. سُيجادل كثيرون فيما بعد بأن هؤلاء جزء عضوي من سنّية النظام، دون إيلاء الاهتمام لهذا التعقيد الثقافي الطبقي وإشكالية الهامش والمركز التي تستحقّ برأيي تحليلاً حقيقياً قبل أن ننفي عن نظام الأسد الطائفي صبغته الطائفية، أو نضع الجميع اليوم في خانة «سنّيةٍ» واحدة في ظلّ ما يحصل.
قيام الثورة كان له في الحقيقة بعدٌ ثقافي غير معلَن. خلخلت بدايةً التنميطات التي حملها السوريون في وعيهم لعقود، وكثيراً ما ترددت عبارة أنّ السوريين لم يعرفوا بعضهم وبلادهم إلّا بعد الثورة. على صفحاتهم الشخصية في فيسبوك، عمد السوريون آنذاك إلى استبدال أماكن ولادتهم بأسماء محافظاتهم المهمّشة: دير الزور، الرقة، الحسكة، وغيرها، بعد أن ادّعى كثير منهم «دمشق» قبل الثورة. كانت الحالة الثورية حالة مؤنسِنة للسوريين جميعاً، وللسوري الذي أُشين في ثقافته الـ«أدنى» على وجه الخصوص. صالحَته مع عار الهامش أمام حلم المواطَنة المفقودة منذ عهد الاستعمار ثم تحت حكم الدكتاتورية التي لطالما لوّحت لنا بأشباح ثقافاتنا المخيفة. كان ذلك في الشهور الأولى على الأقل، حين كانت الحالة الثورية أقلّ تعقيداً، يُعتَقَد أنّ لها ضحيّة واحدة: شعب سوري، ومجرم واحد: نظام قمعي، رغم كل ما يحمله هذا التصوّر من تبسيط. بالمقابل، كان لانتفاء الحالة الثورية في سنيّ الصراع والعنف التالية، وخفوتِها أمام تمدّد وتفرّع الدكتاتورية أثر بالغ؛ لم يقتصر على ترسيخ تركة النظام التنميطيّة فحسب، بل أسهم في إضافة طبقة سميكة من المبرّرات التي شرعَنت نزع الأنسنة عن السوريين القادمين من أسفل هرم الثقافة، تمهيداً للعنف القادم المعمَّم. ستتفتّح لاحقاً أزهار الشرّ، وسينهار كلّ شيء تحت وطأة عنف مستدام. سيُهجّر نصف الشعب السوري، ولن يعرف بلاده إلّا من خلال تلك الصور النمطية العنيفة. ستغدو سوريا مجرّد إطار كبير لتصوّرات مسيّسة ومركبّة كنتيجة حتمية لكل هذا العنف المؤسَّس، بعد أن خرج مارده من قمقم السلطة ليخلق مجتمعات عنيفة تتسابق في نزع الإنسانية عن بعضها البعض. ستضيق سوريّةُ السوريين وتصبح بالنسبة للكثيرين مجرّد منطقة، أو إثنيّة، أو ديانة، أو طائفة بذاتها، وكل ما عداها صورة نمطيّة كبيرة عن سوريات الـ «آخر» المتخيَّلة، تُنتزع فيها الإنسانية عمّن لا يشبهنا، ويتردّد فيها السؤال «ما معنى سوري» هكذا ببساطة فوق الجثث الطريّة.
يعود اليوم سؤال تسييس الثقافة مع مشاركة العشائر في انتهاكات بحقّ السوريين، في غياب لبوادر محاسبة واضحة من قبل السلطة. تتصدّر الشاشات جرائمُ حرب موثّقة في السويداء، بينما يتسلّل في الخلفية صوت مألوف، لهجة تذكّر بسرديّات الثمانينيات عن سوريي الثقافات «المتوحّشة». تحضر الصور النمطية طرفاً فاعلاً في المعركة. تمرّر السلطة مشاركَة الميليشيات العشائرية كقوّة رديفة غير رسمية، بينما تمرّر الصور النمطيّة العنيفة المرافقة لـ «ثقافتها» كقوّة رديفة موازية أكثر خطورة. في المقابل، يستثمر مؤيدو السلطة في هذه الصور النمطيّة. تصبح صورتنا عن التوحّش أداةً سيادية مُحتفَى بها في مفارقة تُضفي على الثقافة العنيفة طابعاً وطنياً. يُعاد تدوير الهامش لا لمصالحته، بل لاستخدامه، بينما تُكرر التنميطات القديمة نفسها بنفسها؛ هذه المرة بوجوه وسياقات سلطوية جديدة.