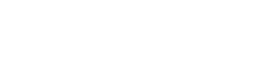التاريخ في عين الشرق .. أنجيل الشاعر
كلُّ من قرأ رواية إبراهيم الجبين (عين الشرق) الصادرة حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، أُعجب بها إلى حد الذهول، وفي الحقيقة كاتب مثله لا ينقصه السحر في الكتابة، كي يذهل القارئ، لكن لا بد من رأي آخر يخالف ما جاء في الرواية من آراء، لكي تتضح الجوانب الأساسية في الرواية، وهي التي تشكل محورها، كالحديث عن السلطة والسياسة والاستبداد الذي طغى على الجوانب الأخرى. وهذا يتوقف على رؤية القارئ لأي نص أدبي أو فكري.
وبما أن الجبين وصف روايته بلعبة “البازل”، فلا بد لأي قارئ من رسم اللعبة التي يتصورها وفقًا لرؤيته الخاصة، لا وفقًا لرغبة الكاتب وتصوره الأيديولوجي-السياسي والديني والاجتماعي.
وفي جميع الأحوال، لعبة “البازل” لا تتفق مع التاريخ، إلا إذا كان التاريخ شيئًا يخرج من الرأس، أو مجرد ترتيب الأحداث (قطع البازل) على هذا الشكل أو ذاك. والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولا يقلل من أهمية الإبداع.
لن أتطرق إلى الجانب السياسي، أو السلطة الاستبدادية التي عرّاها إبراهيم الجبين، كما عرّاها كثيرٌ من الكتّاب والكاتبات من قبل، والأمثلة كثيرة، على وجه الخصوص في الأعوام السبعة الأخيرة؛ إذ صدر، حول الوضع السوري، أكثرُ من اثنتين وعشرين رواية حتى عام 2016، معظمها لكتّاب وكاتبات معارضين ومعارضات، يقيمون خارج سورية، وقد بات القول فيها نافلًا ومعروفًا لدى كل مواطن سوري، وإن كان بعضهم يخفي معرفته بذلك عمدًا، إنما سأناقش الجانب الديني الذي بدأ به الكاتب روايته (وحيٌ من جهة دمشق) والجانب الذي تحمّلت دمشق عبأه على مرّ الزمان، وذلك حسب وجهة نظري في قراءة الرواية.
لم يخطئ الإمبراطور الروماني يوليان في تسمية دمشق “عين الشرق” ولم يخطئ إبراهيم الجبين -أيضًا- في عشقه الجميل المليء بالحنين إلى دمشق، فدمشق هي “تعويذة الكلمات”، كما وصفها الكاتب، وهي عشق لكل من زارها فضلًا عن كل من ولد فيها وترعرع بين حاراتها وأزقتها القديمة قِدم التاريخ، دمشق حافلة بالألم كما هي حافلة بالحب، ولا أتعارض مع الكاتب في هذا الموضوع. فهي مسرح الحضارات الأبدي والحب الأبدي، والوجع الأبدي.
لا يقرأ الكاتب تاريخَ دمشق بعين النابش فحسب، وإنما بعين المدعي والقاضي، أو المدعي–القاضي، ويحكم على كل من مرّ بدمشق، أو حطّ رحاله فيها، أو كلّ من هجرها طوعًا أو قسرًا، وهذا أيضًا من قبيل تأويل “التاريخ” تأويلًا ذاتيًا؛ فيختلط التاريخ بالحكاية التي من نوع حكايات الجدات. معظم الحكايات أو السرديات تحتوي على نوع من التاريخ، بمعناه الشعبي الشائع، تاريخ المكائد والمؤامرات. المؤامرات لا تصنع تاريخًا.
يبدو من الرواية أن الذين قدموا إلى دمشق من أرياف سورية وجبالها وهوامشها، بعضهم حبسوا أنفسهم إما في قصورها وفيلاتها وإما في عشوائياتها البائسة، وبعضهم الآخر حبسوا أنفسهم إما في قلعتها وإما في حاراتها القديمة، كأنهم عائدون للتو من صفين؛ فبدت دمشق كأنها مدينة الغرباء، بعضهم غرباء فيها وبعضهم غرباء عنها، وليست عاصمة سورية.
ابن تيمية الذي مات سجينًا في قلعة دمشق، نقل عصرَه المتوتر الذي كان يتسم بحوادث خطيرة من النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية المضطربة والمتفككة، أدت بالدول الإسلامية إلى الانقسام والتشرذم، نقله إلى هذا العصر الحديث المتسم بالحضارة والتنمية البشرية، فالعقل العربي ما يزال متمسكًا بماضٍ لم يمضِ، يجره إلى الخلف مسافات طويلة.
ما لفت نظري أن كاتبًا يدافع عن اليهود بروح إنسانية شفافة، ويميز اليهودي عن الصهيوني، ويميز الدين اليهودي عن الصهيونية، ويعرض معاناة اليهود وعذاباتهم في الماضي والحاضر، ووجودهم بين مطرقة الغرب الذي لا يعيرهم اهتمامه، وسندان المسلمين والعرب الذين يعدّونهم إلى الآن صهاينة، هو ذاته الكاتب الذي تتنسم منه رائحة الدفاع عن ابن تيمية الذي اعتبر جهاد الابتداء أو الاختيار فرض كفاية، وجهاد الدفع أو الاضطرار فرض عين، ووجوب قتال من بلغته الدعوة ولم يستجب، فابن تيمية اليوم هو “أيقونة” الإسلاميين في التكفير والجهاد، لا في الاجتهاد الذي دعا إليه كثيرٌ من المفكرين الإسلاميين، لكن للجبين رأيًا آخر في ابن تيمية مستندًا إلى أبحاث أوروبية تصفه بالفيلسوف الذي أثّر في مارتن لوثر وإصلاحاته الدينية.
أما تفكيك الطوائف الذي تحدث عنه الجبين، فهو لا يعني تفكيك العصبيات والتعصب الطائفي المستمر منذ زمن طويل في سورية، والذي بات صراعًا علنيًا لا يخفى على أحد.
عبد القادر الجزائري، أوجلان، سلمى، ستناي الشركسية، مظفر النواب، حنا يعقوب، يوسف عبدلكي، أدونيس، صبحي حديدي، سليم بركات، كوهين اليهودي، هائل اليوسفي، المعلم سامي، وغيرهم كثيرون، جميعهم شخصيات تحضر في الرواية بأسمائها الصريحة، وقد عرّى بعضها من القيم الإنسانية والأخلاقية، في ضوء مواقفها من الثورة السورية، من وجهة نظر طائفية بحتة، يبقى السؤال: هل يتوجب على كل مثقف أن يفكر كما يفكر الجبين أو غيره من مناصري الثورة؟ أم يحق لكل إنسان في هذه الحياة حرية التفكير والتعبير عن رأيه بما شكّله عقله واستنتجه من واقع يفرض على الجميع الانخراط فيه؟
كلنا يعرف طريقة إعدام “داميان” الفرنسي التي افتتح بها ميشيل فوكو كتابَه (المراقبة والمعاقبة)، وصنوف التعذيب الجسدي المرير. رأى فوكو أن التعذيب، وغيره وسيلة من وسائل الإكراه التي تستخدمها السلطة كآلية لإنتاج الجسد الطيِّع القابل للتحكم فيه، ويسميها “الانضباطات”، ويعّرف الانضباط بأنه نوع من التشريح السياسي للجسد الذي يهدف إلى تأسيس نمط من السيطرة عليه. ويعتقد فوكو أن تاريخ الجسد مدخل مفيد إلى دراسة السلطة، فالتسلط على جسد الآخرين، لا من أجل أن يحققوا المطلوب منهم فحسب، وإنما ليتصرفوا كما يُراد لهم. هكذا يصنع الانضباط أجسادًا خاضعة، أجسادًا “طيّعة”.
فالسلطة المراقِبة والمعاقِبة لا بد أن تنتج مجتمعًا خاضعًا وطيعًا، ولا يتوجب على المثقفين -كإبراهيم الجبين- السيرُ في هذا الاتجاه بطريقة أدبية تنال من كرامة الإنسان كإنسان، والطائفة كطائفة، والمذهب كمذهب، هذا الخطاب الجديد في الرواية التوثيقية أو التاريخية كرواية (عين الشرق)، لا يتيح للقارئ إلا أن يتعاطف مع طائفة معينة من الطوائف السورية، لا مع الإنسان السوري، وهذا ابتزاز عاطفي اتبعه، من قبل، الكاتبُ خالد الحسيني في روايته (عداء الطائرة الورقية)، إذ جعلنا نتعاطف مع “الهازارا” أو الشيعة على حساب الإنسان.
سئُل إبراهيم الجبين، في حوار أجرته معه قناة (الجزيرة نت): ما الذي دفعك إلى البدء في إنجاز (عين الشرق)، لتكون رواية عن دمشق، وكل هذه الشخصيات من ابن تيمية إلى محمود قول أغاسي، ومن ألويس برونر إلى إيلي كوهين، أيّ الأفكار والصور التي كانت تُلح عليك للبدء في رسم ملامح الرواية، لحظات المخاض إن صح التعبير؟
فأجاب: … ما أردته أنا من استحضار تلك الشخوص، هو الحديث عن القادمين إلى دمشق، وعمّا فعلته هي بهم، وماذا كانوا يريدون من الهجرة إليها، وما حمولتهم المعرفية التي جلبوها معهم. اختلاط الواقع الشخصي بالعام، بالخيال الشخصي والعام، يساهم في إيصال الوثيقة، ويدفع القارئ إلى البحث عن حقيقتها، هل هي من نسج خيال الروائي أم هي وقائع بالفعل؟ لأن دوري ليس دور المؤرخ، لكن المؤرخ يتقاعس عن القيام بدوره، ودوري ليس دور الباحث، لكن الباحث يتقاعس عن القيام بدوره، والروائي والشاعر والصحفي وآخرين. فلنفعل هذا إذن أنا والقارئ بشكل مشترك. ما الذي يمنع؟
السؤال الأهم: هل خرج إبراهيم الجبين من دائرة المثقف السوري؟ أما عرّى نفسه قبل أن يعرّيه؟
لست بصدد الدفاعٍ عن المثقف السوري وخياراته، أو عن طائفة من الطوائف السورية، لكنني أخشى أن يتحول الأدب السوري إلى “توثيق” و”تأريخ” ناشفين وكيديين، أو إلى نوع من لعبة “بازل” قاتلة، وينأى عن رسالته الإنسانية والجمالية بعيدًا عمّا يحمله الإنسان من دين ومذهب وطائفة وقومية وسياسة، تجفف منابع الحب في داخل الإنسان.
عن جبرون