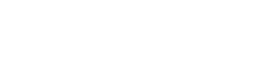كيف أضحى الفيسبوك صديق أمّي المقرّب؟ .. رنوة العمصي
– ماذا تفعلين ؟
– فيسبوك
– مع من تتكلمين ؟
– لا أحد يا أمي
مرارًا، كانت تغلق الباب خلفها غير متأكدة. تسحب الباب على مهل ليختبئ خلفه رأسها المشكّك. ويواصل إبهامي سحب التايم لاين، متصفحًا كل شيء ولا شيء. “أنا فعلًا لا أكلّم أحد” أقول لنفسي، وأعجز في كل مرّة عن أن أشرح لأمي أني لا أكلم أحد، وأن هذا الفيسبوك، الذي يصلني بكل الناس، يصلني بهم، في الغالب، من دون أن أتصل بهم شخصيًا. لكن أمي لا تستسلم، صارت تطوّر أسئلتها حيال هذا الشيء لتعرف ماهيته، كأن تسألني: “شفتِ خالك ع الفيسبوك؟ شفتِ فلان؟ فلانة؟ ماذا أخبروكِ؟ أي ماذا قالوا لكِ لمّا شفتيهم على الفيسبوك؟” هكذا، كأن الفيسبوك شارعًا ألتقي فيه الناس، ألوّح لهم ثم يأخذنا حديث.
بعد وقت، قرّرنا مفاجأة أمي، أو قلّ قررنا التآمر عليها. اشترينا لها في عيد ميلادها آي باد، وحمّلنا عليه الفيسبوك، ثم أنشأنا لها حسابًا هناك. ورغم أن الأمور بينهما لم تسر بسلاسة كبيرة في البداية، إلا أن صبر أمّي وبعض فضول أنثوي لديها، جعلاها تثابر على ارتياد الفضاء الأزرق، أذهلها بداية كيف بدأ الفيسبوك يقترح عليها صداقات لأناس تعرفهم بالفعل، ولأقارب لها يسكنون في بلاد أخرى، حتى ظنت أنه بإمكانه، من نفسه، أن يعثر لها أصدقاء طفولتها بالمدرسة! حسنًا، كانت بادرة طيبة من جانب الفيسبوك، يجدر بي القول!
وعدا أن أمي لم تتوفّر لها دروس كتلك التي قدمتها مكتبات ولاية نيويورك لمساعدة كبار السن في تحسين مهاراتهم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ وتكوين صداقات جديدة على فيسبوك مثلًا، إلا أنها استعاضعت عن ذلك بحفظ أسئلتها التقنية، وتأجيل مهامها الفيسبوكية العسيرة حتى نعود مساءً من أعمالنا، فتقول لي مثلا، “بعد أن تبدلي ملابسك وترتاحي، أريدك أن تساعديني في عمل كذا وكذا على فيسبوك”. ثم لا تقبل مني أن أقوم بما تريد وأنصرف، بل عليّ إعادته مرارًا حتى تتأكد أنها أتقنت الأمر. وحدث بالفعل، أن وجدتها تحمل مفكّرة تضع فيها ملاحظاتها حول خطوات مشاركة صورة أو منشور.
لم تكن أمي وحدها التي بدأت تتلمس طريقها نحو الافتراض، مصادفتها لرفقة جيلها في الأثير، حفّزها، وربما، أشعل منافسة ما حيال تملّك أدوات التقنية واستخدامها. أشهر قليلة، وصار الفيسبوك فقرةً في روتين أمّي اليومي. تستيقظ، تستحم، تحمل حقيبة صغيرة إلى غرفة المعيشة، حقيبة فيها الهاتف الذكي، الآي باد، وشاحنيهما، إضافة إلى نظارتها المكبرة في حاملها الخاص، ودفتر ملاحظاتها التكنولوجية. تشرب قهوتها بصحبة الآي باد والفيسبوك، تمضي ساعتين هكذا، في مشاركة الأدعية الصباحية، حكم وأقوال لاستقبال اليوم الجديد، وتفقّد التنبيهات التي تراكمت أثناء نومها. ثم تترك الأجهزة اللوحية على الشاحن وتتجه للعمل مع معاونتها المنزلية للإشراف على إتمام مهام المنزل. ثم فقرة المساء والتي تحمل طابع التواصل الشخصيّ والإنتاج. إنتاج محتواها الخاص. لقد حفّز فيسبوك أمي على استعادة هوايتها القديمة في كتابة الخواطر. عادت تكتبها وتستذكر، كيف أن أساتذتها في المدرسة شجعوها وتنبأوا لها بمستقبل أدبي، ثم تستدرك، أنتم وتربيتكم أخذتم مني كلّ شيء!
وعدا التصفّح الحثيث، والخواطر، تدرس أمي تفاعلاتها جيدًا على فيسبوك. لايكاتها، ليست عبثًا، وليست أيضًا موضوعية أبدًا. إنها فعل يأتي بعد عملية حسابية ذهنية بالغة التعقيد ليست جودة المنشور إلا أحد عواملها، ولديها نظام أخلاقيّ صارم فيما يخصّ مشاركة المواد وحقوق الملكية الفكرية. فهي لا تقبل أبدًا أن يتم نسخ منشورها، من دون أن تتم الإشارة إلى اسمها، ولا تقوم -حسبما تخبرنا- بنسخ مادة غيرها ووضعها باسمها،“هذا عيب وسرقة”. تقول أمّي.
إضافة إلى أصدقائها الذين تفرّقوا في البلاد، عثرت أمي على أصدقاء “افتراضيين” جدد. فصار لدى أمي البيتوتية هذه القدرة على مدّ يدها لمصافحة وحديث افتراضي مع شخصيات قادمة من الافتراض، لا من الحاضر ولا من الماضي. أكثر من هذا، بدا لي أن الافتراض منحها حقها في الاتصال/ الانعزال في آن. أي الحفاظ على صمت صالونها الذهبيّ، وإبقاء الصخب في حدود جهازها اللوحيّ الذكيّ!
الآن، وبعد أن أضحى الفيسبوك صديقها المقرّب، وجهازها اللوحيّ صاحب الحقيبة المنزلية، لا أعرف إن كنا أحسنّا صنعا بأمي أو تآمرنا عليها باستدراجها للمنطقة التي نقف فيها، بكل تشويشها وتضليلها ومتعتها أيضًا. لكني شعرت ببعض التحسّن بعثوري على دراسة علمية مولها الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع آيجيز 2.0، حول دور التقنيات الحديثة والشبكات الاجتماعية في مساعدة كبار السن على الاتصال والاندماج، أفادت بوجود تأثير ذهنيّ إيجابيّ لتدريب الكبار على استخدام الحواسيب، كما جعلت منهم مواقع التواصل أقل شعورًا بالعزلة، وأكثر تواصلًا ومشاركة.