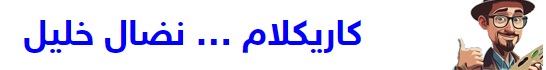أمّي تقود السيارة بين لبنان وسوريا وتتحدى الذكورية .. بشرى مرعي
أمضيت حياتي أتنقل وأهلي بين سوريا ولبنان، في كل إجازة وكل صيف، نحزم أمتعتنا وننطلق إما بالباص فندفع 300 ليرة سورية -هذا عندما كانت سوريا أم الفقير- أو بسيارتنا.
في بادىء الأمر كنا نأخذ معنا أحد الأقارب أو الأصدقاء بسبب خوف أبي من القيادة على الطرق السريعة، ولكن بعد فترة قصيرة سئمت والدتي هذا الوضع وقررت أن تقود هي بنا، حينها كنا جميعاً مندهشين من قرارها هذا، ومتحمسين بسببه. وحينها شعرت أيضاً بأن أمي هي بطلتي، وازداد هذا الشعور في قريتها في سوريا حيث لم تكن في ذلك الوقت فكرة قيادة المرأة للسيارة عادية، أو منتشرة.
كنت أشعر بالسعادة عندما ينظر إلينا طفل في الشارع باستغراب ودهشة، وضحكة مختبئة أكاد أن أراها في عينيه. كنت ولم أزل دقيقة الملاحظة بشكل غريب، كما هي أمي.
في تلك الزيارة كنا كلما نزور أحداً من الأقارب يسعد جداً لكون أمي هي التي قامت بقيادة السيارة من لبنان إلى ضيعتها في جنوب سوريا.
أتذكر أننا في إحدى زياراتنا في تلك الفترة ذهبت مع أمي إلى قرية مجاورة لنزور مقاماً. وكان أهل القرية هذه يتصفون بالتزمت، فهذا ما كنت أعرفه بسبب التقاطي بعض الأحاديث والقصص التي تسردها نساء الحارة في صبحيات المتة مع والدتي. مررنا بالقرب من شابٍ بدا وكأنه في أوائل العشرين من عمره، رمقنا رمقةً عجيبة وقال في صوت استطعنا أن نسمعه: “مرأة وعم تسوق!”. فردت أمي وبصوت مليء بالثقة والسخرية: “بحياتو مش شايف هالشوفة”. في تلك اللحظة شعرت وكأن أمي هي قيادية في ثورة، عنصر من عناصر التغيير، أغمضت عيني وابتسمت ابتسامةً كبيرة من “جوا قلبي”.
بعد فترة قصيرة، في زيارتنا الثانية إلى سوريا بدت الأحوال متغيرة، فرأينا عدداً من النساء يقدن سياراتهن، وكانت زوجة خالي تتدرب لفحص القيادة، وبعد نجاحها أصبحت أول إمرأة في الضيعة تقود سيارة المزارعين من نوع سوزوكي، وكان هذا أيضاً عملاً دعا لاستغراب البعض.
قررنا الذهاب إلى سوريا في بدايات الحرب عام 2012، قمنا بتوضيب أغراضنا، وضعناها في الصندوق، ركبنا السيارة، وتوّلت أمي القيادة، وقبل وصولنا إلى الحدود اللبنانية (المصنع اللبناني)، توقفنا في استراحة “سان رايز” في منطقة شتوره لتصريف النقود والدخول إلى الحمام، كان صاحب الاستراحة قد تعوّد علينا لكثرة سفرنا إلى سوريا وعودتنا منها، سأل أمي هل نحن متجهون نحو سوريا فأجبته بنعم، عندها قال لها “توقوا الحذر لقد حصل تفجير في دمشق”، كان أحد التفجيرات الأولى فيها، صعدت أمي إلى السيارة، استجمعت قواها وباشرت طريقها، ولم تتكلم عن الموضوع قط، حتى إنها حاولت تجاهل فكرة أنني كنت إلى جانبها عندما أخبرها صاحب الاستراحة بأمر التفجير.
كنت ولم أزل أمدّ رأسي من نافذة السيارة وأغوص في خيالي، أو أراقب من في داخل السيارات التي نمر بقربها، وأقرأ كل شخص فيهم. ولكن في تلك المرة، كنت أستطلع أمي وأقرأها، فهي لم تكن على ما يرام، تحاول الغناء مع أبي وأخي، ولكن في داخلها غصة وخوف شديد. بعد تجاوزنا الحدود السورية، وقبل وصولنا إلى الشام بوقت قصير، فتح أخي الراديو، وإذ بخبر حصول التفجير يذاع، عندها اضطرت أمي إلى القول لأبي وأخي ما قاله لنا صاحب الاستراحة.
مررنا بالشام، ولحسن حظنا ولتعاسة حظ من انفجروا وتأذوا، كان مكان التفجير بعيداً قليلاً عن طريق دمشق – السويداء.
لم ألم أمي ولو للحظة لاتخاذها قرار إكمال الطريق نحو سوريا وعدم العودة على الرغم من معرفتها بحصول التفجير، وكأنها علمت أنه لن يصيبنا مكروه، أو لأن انتماءها لبلدها دفعها لإكمال الطريق.
استمرت الحرب، واستمر سفرنا إلى سوريا، وتعرضنا لمواقف عدة، برهنت أمي في كل مرة أنها أقوى مما نتصور.
بعد بدء أزمة انقطاع البنزين في سوريا اضطررنا للحد من زياراتنا، وعند وجوب سفرنا نستقل إحدى السيارات التي تعمل على الخط الدولي لسوريا ولبنان، وكبر أخي ولم يعد يحب الذهاب إلى سوريا، حيث لا مكان للفكر المشترك معه هناك، وذلك لأن معظم من يقاربنا في العمر اختاروا اللجوء والفرار من الجيش عوضاً عن المقاتلة ضد عدو غير محدد ولقضية غير مفهومة، وعوضاً عن الموت.
إذ ذاك أصبحت أسافر أنا وأمي وحدنا، مع العلم أنه كان باستطاعتي في كل مرة أن أرفض الذهاب إلى سوريا لنفس الأسباب التي جعلت أخي يتوقف عن السفر معنا، ولكنني دائماً كنت أذهب لأنني أشعر بأن هناك شعوراً ينقصني، إحساساً غريباً أحبه، لا أشعر به سوى عند وصولي إلى سوريا، كان هناك ما يجذبني إليها وهي في خضم حربها، كنت أبحث عن أحداث إذ لا أحب الرتابة.
بعد فترة من عدم السفر بسيارتنا الخاصة، قررت أنا وأمي السفر بها، وفي يوم انطلاقنا وعند وصولنا إلى الحدود السورية تعرضنا “للبهدلة والشحار” كما كل الناس التي تمر بها. فظاظة من يعمل هناك زادت عليها ذكورية من يمضي أوراق السيارة، فيقوم باستغلال فكرة أن إمرأة تقودها فيتوقع أنه يستطيع أن يرتشي بالكم الذي يطلبه.
إضافةً إلى هذا تتمثل الذكورية عندهم بأشكال أخرى، منها أننا إمرأتان بمفردنا، فكيف لنا أن نقطع كل هذه المسافة وحدنا، فيكون جواب أمي بالمرصاد دائماً، أما الشكل الثاني فهو أن شباباً عدة يقفون طوال النهار إلى جانب الكوخ الاي تُمضى فيه دفاتر السيارات ومعاملاتها، فيأتون من منطلق أننا نساء ولا نفهم في معاملات السيارات “واللبكة” التي يصنعونها هم للحصول على نصيب من النقود.
تطور تفكير أهل القرى كثيراً منذ أكثر من عقد من الزمن حتى يومنا هذا، وتغير نمط العيش لديهم في العديد من الأمور. لكن استخفاف الذين يعملون في الحدود اللبنانية والسورية بامرأة تقود سيارتها وحدها وتسافر بها من بلد إلى آخر غير مبرر. إن هذه الأفعال من الأمن والعسكر غير مبررة ولكن غير مفاجئة، لأنهم تتلمذوا على أيدي أنظمة صيتها السيىء سابقها.
تمر المرأة في بلداننا بعدة تحديات تريد أن تكسر بها الذكورية التي تشكل عائقاً في حياتها. ومن أصغر الأمثلة على ذلك، هو تحدي أمي لقيادة سيارة تنتقل بها بين بلدين لا تزال المرأة فيهما غير قادرة على ممارسة كامل حقوقها، والعيش براحة من دون أن يعرقل حياتها فكرٌ ذكوري ما برحت ترسباته ماثلة في عقول أشخاص يُعتبرون عنصراً معرقلاَ من عناصر كثيرة نضطر إلى أن نواجهها كنساء أولاً وكشعوب كان نصيبها أن تولد في هذه البلاد ثانياً.