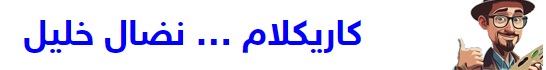على هامش المحنة السوريّة: أيّة كتابة؟ .. منصف الوهايبي
كلّ محنة إنسانيّة عظيمة، كهذه التي يعيشها الشعب السوري؛ حتى أنّها تكاد تحجب عنّا المأساة الفلسطينيّة، هي أقرب ما تكون إلى الأسطورة.. لأقلْ هي لغة رفيعة، ينسلخ فيها المعنى عن الأساس اللغوي الذي يجري فوقه، فيمّحي النصّ الأوّل غير المقروء، ومعه يمّحي كلّ العمق الذي لا ينضب أي عمق الكلمات حيث هذا السوري أو هذه السوريّة.. لأقل هذا الكائن الأخرس وهو يرفع سبّابته في وجوهنا نحن جميعا.
لا أحد بمقدوره أن يملي على السوري كيف يكتب هذه المحنة، ولا هذا من حقّه. فهذا سياق اجتماعيّ تاريخيّ يثير مجادلات وسجالات إيديولوجيّة شائكة، فضلا عن أنّها محنة تقول وتخفي. وهي مع ذلك تعرّينا، وتضعنا في مواجهة أنفسنا.
محنة تمهّد السبيل إلى معرفة أو كتابة مغايرة.. وتجعل المرئيّ مرئيّا؛ وهي تومئ إلى لحظة تاريخيّة تنشأ أو هي تُنجز حيث المستقبل السوري أشبه ببذرة أو إمكان في فضاء مشرع على احتمالات شتّى. تتجذّر هذه المحنة شأنها شأن قرينتها الفلسطينيّة في «ما وراء اللغة»، وتنمو مثل بذرة، وليس مثل خطّ. وفيها وبها يمكن للكاتب السوري قبل غيره، أن يرى مُكْتنَهَ التقاء الذات والتاريخ، واللغة والإيديولوجيا؛ بمنأى عن هذه الثنائيّات العامّة التي يتنامى فيها الخطاب السياسي البراغماتي: النظام/ المعارضة أو الشرّ/ الخير أو الجلاّد/ الضحيّة وما إليها؛ فهذه على جدارتها السياسيّة، تلوح معزولة عن سياقها الاجتماعي التاريخي؛ وكأنّها ثنائيّات ميتافيزيقيّة ثابتة تحيا خارج الزمن أو خارج التاريخ، وتكاد تحوّل المحنة السوريّة إلى معادلة رياضيّة فيزيائيّة يمكن استنساخها وتكرارها؛ فيما هي أفق منفتح، ولغة يصعب علينا نحن البعيدين، تأويلها بغير لغتها المتوتّرة المتقطّعة ولسانها المبهم.
وهذه محنة تكاد في كلّ منعرج تأخذنا من بداية ربّما هي لم تكن مفاجئة للسوريّين الذين يعانون منذ عقود، إلى نهاية، ثمّ من نهاية إلى بداية، وتقفز بنا من قمّة إلى أخرى؛ فوق هاوية أو أرض براحٍ، تعجز عقولنا عن أن تجسرها أو تملأها؛ فيما هي عند السوري قد تكون العمق الذي يصل ويربط كلّ هذه القمم بعضها ببعض، أو يجعلها تتواصل على نحو من الأنحاء، في حوار الذات مع الذات حيث التعدّديّة والانفصام، والمتناهي واللامتناهي يسيران يدا بيدٍ.. حيث العلوّ باطن في الموجود نفسه.
لا أحد ـ ما عدا الضالعين في الجريمة ـ ينكر اليوم أنّ هناك طائفيّة تَبِينُ عن وجهها البشع في قتل الناس وتهجيرهم بأشدّ الأسلحة فتكا، ولكن ينبغي الحذر، واجتناب التعميم؛ فليس كلّ من ينتمي إلى هذه الطائفة أو تلك، هو طائفيّ ضرورة.
نقول هذا ونحن نعرف أنّ بعض هذه الطوائف تتقنّع بالتقيّة، في علاقة أتباعها ومريديها بالآخرين، وتؤكّد أنّ مبادئها وتعاليمها سرّ مصون، لا يجوز إفشاؤه أو إذاعته. وهي تلزم أتباعها ذلك إلزاما يبلغ حدّ تكفير من يجرأ منهم على كشفها أو الاستهانة بها. فضلا عن أنّ لبعضها كتبا سريّة يتداولونها فيما بينهم. وإذا أمكن لبعض المستشرقين نشر بعضها، فإنّ أكثرها مخطوط، لا يزال مجهولا. وفي مستهلّ الثمانينات أطلعتني السيّدة سيغريد كاهل ابنة المستشرق السويدي نوبرغ، وكنت وقتها أساعدها في ترجمة نماذج من شعر أدونيس، على بعض هذه النصوص السريّة. ثمّ ضاعت منها، كما أخبرتني قبل وفاتها بمدّة؛ إذ استلمها منها مسؤول سوريّ كبير في الجامعة العربيّة بتونس، بغية فحصها ومساعدتها في فهمها؛ ثمّ رفض أن يعيدها إليها، متذرّعا بأنّه افتقدها. على أنّي لا أزال أحتفظ بشذرات متفرّقة منها، وأكثرها صور استعاريّة ملغزة: الإنسان الذي يظهر الإله بصورته ويخلق بيده ويأمر بلسانه، أو يسكن السحاب، وصوته الرعد وضحكه البرق، أو هو حالّ في القمر عند بعضهم وفي الشمس عند طائفة منهم، وما إلى ذلك ممّا يتعلّق بصاحب الحجاب والباب الذي يفضي إلى الحكمة، وأسرار الباطن وباطن الأسرار، وتقديس شجرة العنب، وتخليص اللاهوت من الناسوت، وجواز ظهور الروحاني بالجسد الجسماني… وبعضها شبيه بحلوليّة لاوتسو في فلسفة «الطاو» حيث الأرض رمز للظلّ والبرودة والأنوثة، فيما السماء رمز للنور والحرارة والذكورة، والناس مزيج من عناصر سماويّة وأرضيّة وذكوريّة وأنثويّة.
ومع ذلك فالسوري كان ولا يزال ينتمي إلى مكان بعينه وزمان بعينه؛ وليس إلى الأمكنة جميعها والأزمنة جميعها، كما نقرأ في بعض الشعر السوري والعربي الحديث الذي يلامس اللغة ولا يلامس هذه المحنة. وقد يتذرّع بعضهم بـ»الكونيّة» حينا و»العولمة» حينا آخر، تأسّيا بفكر الاختلاف، هذا الفكر الذي يرفض أن يكون الغرب «مركز إشعاع» إذ هو في تقديرهم ما انفكّ يستهدف نواة الحضارات الأقدم، ويستنزف عمقها الثقافي، ويسعى إلى إرساء رؤية ذات بعد واحد، من شأنها أن تقمع كلّ فكر مغاير أو مخالف، وكلّ من يرفض أن يرى نفسه في مرآتها، أو ينخرط في لعبتها.
قد يكون هذا النزوع إلى الاختلاف أو إلى معارضة الأنماط الفكريّة السائدة، حقّ الكتّاب والمبدعين والمفكّرين عامّة؛ ولكنّه في محنة كالتي نحن بصددها، يغدو ترفا أو نرجسيّة فكريّة بل هو ينافي فكر الاختلاف نفسه.
يقول أبو حيّان التوحيدي في «الليلة الثلاثين» من «الإمتاع والمؤانسة» إنّ الشيء قد يوصف بأنّه واحد بالمعنى وكثير بالأسماء، وواحد بالاسم وهو كثير المعنى، وواحد بالجنس وهو كثير بالأنواع، وواحد بالنوع وهو كثير بالشخوص، وواحد بالاتّصال وهو كثير بالأجزاء، وواحد بالموضوع وهو كثير بالحدود… ونقدّر أنّ فكر الاختلاف يصعب أن يجري في غير هذا المنحى «المفرد الجمع»، أمّا عدا ذلك؛ فليس سوى الجحيم الأرضي حيث يجد الفرد (السوريّ المقيم أو المهاجر داخل أرضه أو خارجها) نفسه موكولا بنفسه، منغلقا عليها، غريبا عن الآخرين، غريبا حتى عن نفسه.
وإذ تضيع «الأنت» تضيع «الأنا» وهي المحدّدة اجتماعيّا، منذ البداية، ولا يكون سوى الموت الممكن الذي هو مصيرنا جميعا؛ وليس الموت الحدث الذي يمكن أن يؤنسن الزمن، وأن يتحوّل إلى ضرب من الكشف، يكتشف به الانسان وجهه وينفذ إلى انسانيّته.
ونحن ندرك، وهذا ليس عزاء للسوريّين، أنّ الحياة في سوريا؛ لا تتوقّف بهذا الموت الدمويّ اليوميّ، بل هي تحيا به، وتمتدّ وتتواصل في هيئات وأشكال جديدة. بل الموت من حيث هو تعبير عن ارتباط الفرد بالنوع. وفي سوريا عُثر في القرن الماضي، على هياكل بشريّة مكوّرة في هيئة أجنّة؛ وقد أحيطت ببعض الأواني، حتى لكأنّ العودة إلى القبر هي عودة إلى الرحم؛ بانتظار ولادة جديدة، أو أنّ المروّع بداية الرائع، أو أنّ الزمن نفسه زمن انسانيّ يتميّز عن ديمومة الأشياء والكائنات الأخرى، ويعلّمنا أنّ الإنسانيّة وحدة، وأنّنا نسغها موتى وأحياء. بل هو زمن يعلّمنا أنّ اللحظة التي حفر فيها الإنسان قبرا، هي ذاتها اللحظة التي بدأ فيها يحفر طريق الحضارة، ويردم الحيوان فيه. صحيحٌ أنّ الموت يجتثّ التوازن العضوي، ولكنّه يحرّر قوّة الحياة المكبّلة في الجسم.
لا أحد يملي على المبدع السوريّ كيف يقول هذه المحنة أو يكتبها، أو أن يطابق بين فكره وواقعه؛ والكتابة ليست من باب الرياضيّات، ولا هي من معادلات الأرقام المجرّدة، والمثلّثات والدوائر وما إليها؛ وإنّما هي بطريقة أو بأخرى، معادلات للانفعالات الإنسانيّة.
والكتابة ليست تصنيفا، وكلّ تصنيف قد لا يكون أكثر من ضرب من ضروب القمع. والكاتب السوري شأنه شأن أيّ كاتب عربي، يجابه قمعيْن اثنيْن أو سلطتيْن هما قمع اللغة وقمع التراث؛ وكلاهما مؤسّسة اجتماعيّة أو عقد اجتماعي، ولكنْ هناك قمع النظام «مؤسّسة الانغيار»( وهذا مصطلح من نحت أستاذنا الراحل صالح القرمادي، وهو يعني معنى من معاني الاغتراب أو الفناء في الغير)؛ وهذه المؤسّسة لا هدف لها سوى تحويل المواطنين جميعهم، إلى مثال واحد؛ إذ هي لا تتقبّل الأبعاد المفقودة، أو هذه المسافة، أو هذا العدول الذي يُفترض أن يعقد صلة خاصّة بين الفنّ والواقع؛ وبفضله يظلّ التوتّر بين الراهن والممكن قائما.
الزمن في سوريا اليوم هو «زمن القتلة»، وقدر المبدع السوريّ أن يختطّ لنفسه طريقا للخروج من هذا التناقض المرعب بين «الحياة» الواقعيّة في وطنه، وفنّه؛ أو أن يبدع وينشئ تحت وطأة الإحساس أو الانخطاف بالحاجة إلى سماء مضادّة؛ حتى يتحرّر ويحرّرنا من المؤسّسة التي تملؤنا بوهم الامتلاك، وتقتل فينا كلّ نزوع إلى إنسانيّتنا أو «كَينونتنا». المؤسّسة التي تجتثّنا قبل أن يحين حيننا، قبل أن يحلم الموت فينا؛ فإذا «نهايتنا تسقط في أعماقنا، ثمرة فجّة حامضة لم تنضج بعد». تلك هي الحريّة، إذا اعتبرنا الحريّة معرفة بالقوانين التاريخيّة والاجتماعيّة، وتوظيفا لها في سبيل الأفضل والأجمل.
كاتب تونسي | القدس العربي