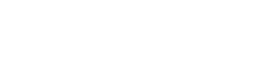قراءة في واقع الدولة السورية اليوم .. مرهف مينو
في خضم الفوضى الإعلامية والتحليلات المتسرعة التي تسود المشهد السوري، لا بد من التوقف ملياً أمام بعض الأصوات التي تخرج لتُحمِّل الحكومة السورية الحالية مسؤوليات بحجم وطن، بل وتحمّلها تبعات عقود من الخراب المتعمد الذي مارسته السلطة السابقة.
ولعل أكثر ما يثير الاستغراب هو اختزال المشكلة السورية العميقة والمعقدة في مسألة اعتقال مجرم أو تأخر محاسبة فاسد، وكأن التاريخ بدأ بالأمس، وكأن الخراب الذي عاشته سوريا منذ عام 2011 قد حدث في يوم وليلة.
أصوات بعضها بريء، وبعضها مراهق، وبعضها مغرض، تتساءل: لماذا تأخرت الحكومة في القبض على فادي صقر وأمثاله؟ ولماذا لا تُحاسَب رموز الإجرام السابق بسرعة؟
لكن الحقيقة التي يجب أن تُقال بصراحة: هذه الحكومة لم تنتصر على النظام السابق بتنظيمها العسكري أو بقوتها الأمنية، بل انتصرت لأنها امتداد لهذا الشعب، من صلبه، ومسنودة بدمه وصبره وتضحياته.
إن الثقة في هذه السلطة ليست عاطفية، بل مبنية على إدراك عميق لطبيعة المرحلة، وفهم تاريخي لما مرّت به سوريا.
نعم، معركة التحرير الأخيرة استغرقت 11 يومًا ومر عليه أربعة شهور، ولكنها في الحقيقة ثمرة نضال عمره 14 سنة من التضحيات والمقاومة.
والسؤال الأهم: من الذي فرّط بسوريا؟ من الذي جعل الجيش السوري عقديًا طائفيًا، حتى أصبحت المناصب القيادية فيه حكراً على أقلية بعينها؟ من الذي دمّر البنية الأمنية والعسكرية للدولة، واستبدل الجيش السوري بمليشيات إيرانية وعراقية ولبنانية وأفغانية؟
الجيش السوري في عهد المجرم بشار مثل مؤسسة مثقلة بالفساد والمحسوبيات، وهو أقرب إلى مشروع اقتصادي للأقلية الحاكمة من أن يكون جيشًا وطنيًا.
وكانت النتيجة انهياره الكامل، ليحل محله ما نراه اليوم من بقايا فلول مسلحة لا ولاء لها إلا للطائفة والخارج.
من المؤسف أن البعض لا يزال يقع في فخ التحليلات الساذجة التي تروج لنظرية “المؤامرة”، وتدّعي أن النظام السابق انسحب طوعًا لتوريط الحكومة الحالية. لكن هذه قراءة سطحية تُهمل الحقائق. حلب، حين تحررت، كان فيها أكثر من 30 ألف مقاتل أجنبي من مليشيات المخلوع بشار، بينهم عراقيون وإيرانيون، تمت عملية تهريبهم من قبل الروس، وكانوا في حالة انهيار كامل. فكيف لمن كان في طريقه إلى الزوال أن يُدبّر مؤامرة؟
الحقيقة التي يجب أن تُفهم هي أن الانتصار العسكري الذي تحقق لم يكن بفعل قوة عظمى أو جيش جرار، بل تحقق بفضل 25 ألف مقاتل سوري فقط، معظمهم أبناء هذا الشعب.
هؤلاء قاتلوا في حلب وحماة وحمص ودمشق، وكانوا يعودون إلى أهاليهم في كل منطقة يدخلونها.
إنها معادلة النصر التي أثبتها التاريخ الإسلامي مرارًا: الأقلية المؤمنة تنتصر، حين تكون مدعومة من شعبها.
لكن، رغم النصر، فإن التحديات لا تزال هائلة. من يتحدث عن دولة طبيعية في سوريا اليوم، يتجاهل الحقائق: لا خريطة وطنية مكتملة، بفعل الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب والوجود الكردي المدعوم أمريكيًا في الشرق.
لا شعب موحد، حيث أكثر من 10 ملايين سوري يعيشون في الشتات. ولا سلطة كاملة، حيث لا تزال الدولة تفتقر إلى الموارد والقدرات الأمنية لتأمين البلاد بالكامل.
الدولة اليوم بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 ألف عنصر أمني لتغطية البلاد، لكن ما تملكه هو نواة أمنية لا تتجاوز بضعة آلاف، وهي بالكاد كافية لتأمين مناطق محددة.
لهذا لا بد من إدراك أن هذه السلطة تمثلنا، وتعكس إرادتنا، وتحتاج إلى دعمنا لا إلى التشكيك الدائم بها.
نعم، هناك قصور، وتأخير في المحاسبة، وأخطاء قد تبدو فادحة. لكن لنتذكر أن هذه السلطة لم ترث دولة، بل دماراً. ولم تُسلم مؤسسات، بل أطلالًا وخرائط مفخخة.
علينا أن نصبر لا على الحكومة، بل على أنفسنا، لأن هذه السلطة “منا وفينا”، ولأنها تُجاهد اليوم في ظل امتحان عسير، تحاول من خلاله إعادة بناء وطن تمزق على أيدي سفاحين وقتله يعتبرون الوطن هو الطائفة.
ما نحتاجه ليس المزيد من الأصوات التي تشكك، بل خطاب وطني موحد، واعٍ، يُدرك أن التمكين لا يأتي بين يوم وليلة، بل هو ثمرة صبر وتلاحم وثقة، وهي ثلاثية لا يمكن لأي دولة أن تنهض بدونها.